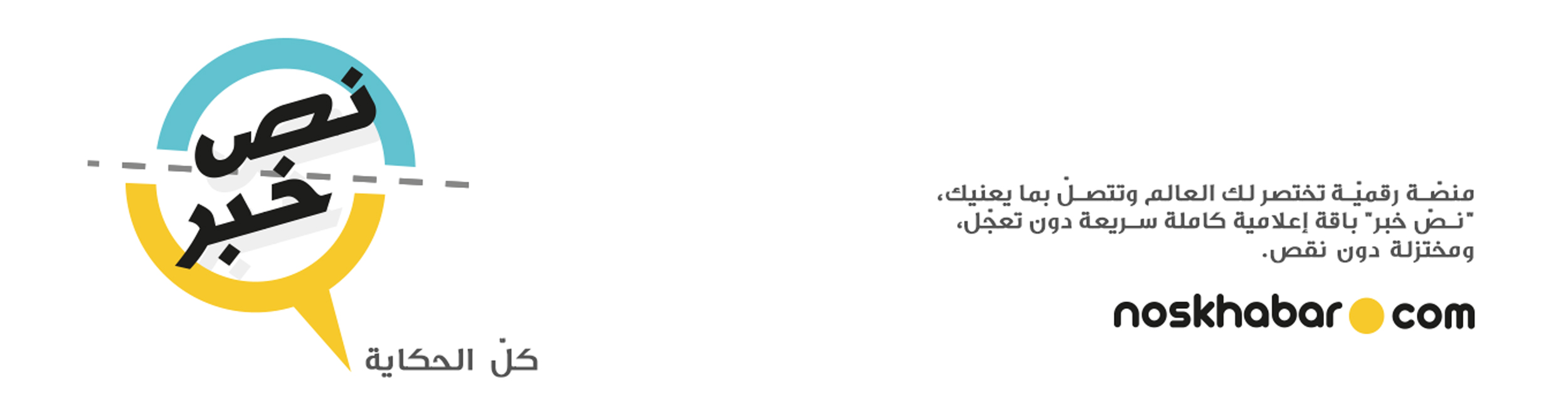14 أوغست 2023
حاورها: هاني نديم
انتقلت نور حريري بجرأة وشغف من الطب إلى الهندسة ثم إلى الفلسفة حيث عشقها الأول، خالفت بذلك الذهنية الشرقية التي تقدس الطب والهندسات، ولعل هذه الخطوة تشكل مدخلاً أساسياً لشخصية مبدعة تدافع عن رموزها وتلتزم باشتغالاتها.
نور حرير اليوم تترجم وتكتب في الصحافة، كما أنها تقدم برامج فلسفية إلى جانب نشاطها النسوي المستمر، وفي كل هذا تقدم نور نموذجاً جاداً للمثقف الذي نحتاجه في أوطاننا، المثقف المشتبك والمحاور والمنفتح على كل الأفكار.
التقيتها في هذه الدردشة السريعة، سالتها:
- بين الترجمة والفلسفة والنسوية والصحافة، تتجولين ضمن هذا المربع إن كنت مصيباً، رتبي لي شغفك وبودي لو عرفت ماذا تترجمين؟
صحيح، أتجول ضمن هذا المربَّع، وقد صار مخمَّسًا ومسدَّسًا مؤخرًا مع دخول عملي الأكاديمي والإعلامي إليه. لكن في الحقيقة ما أتجول ضمنه ليس مربّعًا أو مخمّسًا، هو دائرة. ووحدها الفلسفة تقع في قلب الدائرة، في قلبي، بلا شركاء. أما بالنسبة للترجمة والصحافة والنسوية وغير ذلك، ففي الحقيقة، لا أعدّ نفسي مترجمة أو ناشطة نسوية أو غير ذلك. كل ما فعلته هو أنني ترجمت كتبًا في الفلسفة، وقدّمت برامج صوتية ومرئية في الفلسفة، وكتبت في قضايا كثيرة من بينها النسوية من منظور فلسفي. إذًا، هذه الممارسات هي عُدَّة الفلسفة وعتادها: اللغة من خلال الترجمة، المرونة من خلال الصحافة، الرأي الآخر من خلال الإعلام، هذا مجال التجربة والعمل ووضع الأفكار على المحكّ، ما يحمي الفلسفة من الانغلاق على نفسها، ويُجنّبها الوقوع في فخ استسهال الإجابة عن مشكلات الواقع المعقّدة.
اليوم، الاحتكاك بالواقع صعب. التجربة، بمفهومها الفلسفي، تكاد تكون غير موجودة، وقد تحدّث كثير من الفلاسفة عن قضية موت التجربة. إمكانية التجربة السياسية مثلًا صعبة ومعقّدة لأسباب خارجة عن إرادتنا. إمكانية التجربة العاطفية الأصيلة نادرة جدًا. فتبقى التجربة الثقافية التي أعتقد أنها لاتزال متاحة. لذا أخوض التجربة الثقافية من زاوية فكرية فلسفية.
أعمل حاليًا على ترجمة كتاب “ذوات راغبة” للفيلسوفة الأمريكية جوديث بَتلر.
علاقتي بالفلسفة متناقضة، شخصية وسياسية، علاقة كينونة وصيرورة، حرية وسلطة معًا. ومن حيث الأداء، أصفها بالبركانية.
- كيف كانت البدايات وما المنعطف الذي ساقك نحو الفلسفة وكيف تصفين علاقتك بها؟
هناك ثلاثة منعطفات ساقتني نحو الفلسفة (على الطريقة الهيغلية)، لكن البدايات نفسها كانت مشوَّشة. فقد درست الطب ثم تحوّلت إلى الهندسة. كانت مهاراتي العلمية عالية نسبيًا، فلم أتعامل بجدية مع اهتمامي بالفلسفة والأدب والشعر. وهذا الأمر وثيق الصلة بثقافة مدينتي التي وُلدت وعشت فيها وهي حلب. حلب مدينة متناقضة، منفتحة ظاهريًا ومنغلقة ومحافظة ضمنيًا، وأسلوب التفكير السائد فيها براغماتي، لذا كانت غاية التعلُّم إما العلم (الطب والهندسة) أو العمل (الصناعة والتجارة) لا غير، والثقافة المنتشرة فيها هي ثقافة “عالية” تقبل أنواعًا فنية معينة وترتبط بطبقة اجتماعية معينة. الاهتمام بالفلسفة والأدب ضعيف في مدينة حلب. وعلى الرغم من أنني كنت على الجهة المُستفيدة من هذه الطبقية والثقافة “العالية”، فلم أقبلها إطلاقًا.
لذا، كان المنعطف، هو الاصطدام بثقافة مدينة حلب، حيث تشكلت الأسئلة الفلسفية الأولى عن دور العوامل التاريخية السياسية والاقتصادية ثم الدينية، في تشكيل الثقافة وتشكيل العلاقات بين الناس وبين الناس والسلطة. إذًا، المنعطف الأول كان ثقافيًا عامًا. أما المنعطف الثاني، فكان خاصًا، كان اجتماعيًا وعاطفيًا، حيث بدأ الاصطدام مع الآخر ومع عوالم اللغة، وبدأت الأسئلة تأخذ طابعًا نفسيًا وشعريًا وتتحوّل من أسئلة مجرّدة إلى قراءات جدّية وممارسات ملموسة بدأت بترجمة الفلسفة.
المنعطف الأخير هو الأهم وتزامن مع انتقالي إلى ألمانيا، لا ينتج هذا المنعطف عن اصطدام، أي أن حركته ليست سلبية هذه المرة. الفلسفة في هذه المرحلة لم تعد أسئلة، ولا قراءات، بل صار لها موقف سياسي واتخذت أخلاقيات معينة، فأصبحت رغبة محدّدة وخطة واضحة أسير فيها ببطء وحذر شديد من خلال ما أدرسه وأمارسه وما أخطط لفعله. ولذلك، كان المنعطف الأخير سياسيًا من حيث الطبيعة، يحمل عاطفية من المنعطف الثاني، وبراغماتية من المنعطف الأول. أصف علاقتي بالفلسفة بأنها متناقضة، هي شخصية وسياسية، هي علاقة كينونة وصيرورة، حرية وسلطة معًا. ومن حيث الأداء، أصفها بالبركانية.

- تعيشين اليوم في أحد مراكز الفلسفة على مر التاريخ برلين، بماذا أفادك؟
لا شك أن وجودي في ألمانيا أفادني، لكن الأدق ربما هو أن أقول إنني استفدت من وجودي فيها. أتاحت لي ألمانيا فرصة دراسة الفلسفة والتعرف إلى فلاسفة ألمانيين وعالميين، لكنها ليست فرصة مجانية أو عملية سهلة ومتاحة للجميع، تطلَّب ذلك تعلّمَ لغتين بالإضافة إلى اللغة الإنكليزية للحصول على القبول، وتطلّب كثيرًا من الدراسة والترجمة للنجاح ثم الحصول على فرصة عمل، وكثيرًا من القراءة والمتابعة لإثبات الجدارة والتمكن من الدخول في دوائر الفلاسفة الضيقة. لكن بمعزل عن الجامعة والفلاسفة، وجودي في ألمانيا في حدّ ذاته كان له وقع خاص في نفسي.
منذ مغادرتي البلاد لم أعد قادرة على سماع موسيقاها، كل ما تحمله الذاكرة عن البلاد أصبح مؤلمًا ومنهكًا
لم أنظر إلى ألمانيا يومًا على أنها بلد اقتصاد، أو بلد حرية، أو غير ذلك كما ينظر إليها الآخرون. كانت بالنسبة لي من الأساس بلد الفلسفة، ولم أعتدها كبلد عادي حتى هذا اليوم. أنظر إليها بعيون الفلسفة ولا يفارق ذهني تاريخها الفلسفي والسياسي ما جعلني أتقفى آثار الفلاسفة فيها، الحيّ منهم والميت، زرت بيوتهم وحدائقهم وقبورهم وتعرفت إلى أبنائهم. مشيت في الغابات التي مشوا فيها، وجلست في قاعات درّسوا فيها.

- وكيف هي العلاقة بين الفكر الفلسفي الألماني والعربي، هل يعرفوننا جيداً وأفادوا من فلسفاتنا القديمة أم أن هنالك مبالغة عربية في هذا؟
لا شك أنها مبالغة. العلاقة بين الاثنين شبه معدومة اليوم. هم بالتأكيد لا يعرفوننا، لكن نحن أيضًا لا نعرف أنفسنا، ولا نعرف كيف نعرّف عن أنفسنا أو نطوّر من أنفسنا أو نقدّم ما يُثبت عكس ادعاءاتهم. القدماء من الفلاسفة أفادوا من فلسفاتنا القديمة، لكن هذا لا معنى له اليوم، فاليوم لا يوجد إنتاج فلسفي أو علمي عربي، والعودة إلى الأصول في الفلسفة أو غيرها ليست سوى محاولة نفسية بائسة للهروب من واقع تصعب مواجهته، ولن يُواجَه إلا بعودة أصولية أشدّ من جهتهم. لا يمكن إلقاء اللوم على الآخر وحده. هناك مسؤولية تاريخية كبرى على الآخر نعرفها تمامًا، لكن هناك مسؤولية أكبر تقع على عاتقنا. إذًا، هي مشكلة من الجهتين، لكنّ حلها لا بدّ أن يأتي من جهتنا نحن، ولا يتمثّل، كما نرى بصورة شائعة اليوم، في محاولات شيطنة الآخر الغربي وتقديس الذات العربية، ولا في تقديس الآخر الغربي وشيطنة الذات العربية، ولا في الغرق مثاليًا في الأصول الثقافية والدينية لمشكلات مادية معقدة نعيشها اليوم، بل في العمل المادي الملموس والإنتاج المعرفي والثقافي ووضع المشاريع الوطنية والسياسية المتكاملة.

- حدثيني عن نور خارج الفلسفة والمنجز، الحياة اليومية، الأصدقاء، عن مفهوم النسوية لديك، عن البلاد البعيدة وعنك؟
ربما أستطيع أن أتحدث عن نفسي خارج المنجز، لكن ليس خارج الفلسفة، فالفلسفة التي أنتمي إليها هي الحياة نفسها حين تكون مغامرة متطرفة، ورغبة لا يُشبعها شيء فتُطلَب بتناقضاتها، خيرها وشرها ونقصها الجميل. بعيدًا عن المنجز، أحب الموسيقا والشعر، لكن منذ مغادرتي البلاد البعيدة لم أعد قادرة على سماع موسيقاها، كل ما تحمله الذاكرة عن البلاد أصبح مؤلمًا ومنهكًا. لذا ألجأ إلى موسيقا أخرى أستطيع أن أبقى على مسافة منها، أو إلى الفلسفة التي تساعدني على تحليل واقع تلك البلاد وفهمه، آملة أن نتمكن يومًا من تغيير هذا الواقع.
لا أحب العاطفة البكائية أو حالة التطهّر من خلال الفن والأدب، لذلك ألجأ إلى العمل والإنتاج. أقدّس العمل أيًا كان نوعه وأحترم العاملين والعاملات. وأحب الصداقات التي فيها قليل من العمل المشترك، وأحب المسافات في العلاقات، شرط أن تكون مساميّة كمسام الجسم التي تتيح المنافذ إلى جسم العلاقة بكامله. في الأشخاص والأماكن والأشياء، أبحث باستمرار عن “الدويندي”، الذي عرّفه الشاعر الإسباني لوركا بأنه “روح خفي”، وهو يشبه الروح عند هيغل، وهو يحمل الخير الذي في مسحة شر جميل، ولا يمكن لعاطفة حقيقية أو جمال أصيل أن يوجد من دون الدويندي. الصداقات قليلة جدًا. أعوض عن غيابها بقهوة صباحية في مقهى، أو بـ “تمشاية” ليلية في أزقة برلين، وساعات طويلة من القراءة. أما النسوية، فأزعم أن نسويتي تختلف عما هو نسوي سائد. تؤلمني معاناة النساء ومشكلاتهن وما يتعرّضن له من تعنيف وحرمان، لكن تؤلمني أيضًا معاناة الرجل الصامتة. لذا، أرى أنه من الضروري أن تنظر النسوية في قضايا الرجل التي ترتبط جوهريًا بقضاياها، من دون الاستسهال الخروج بالنتائج. أي تحليل، نسوي أو غير نسوي، لا يتعامل بجدية مع العوامل المختلفة، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والنفسية، لا أتعامل معه بجدية.