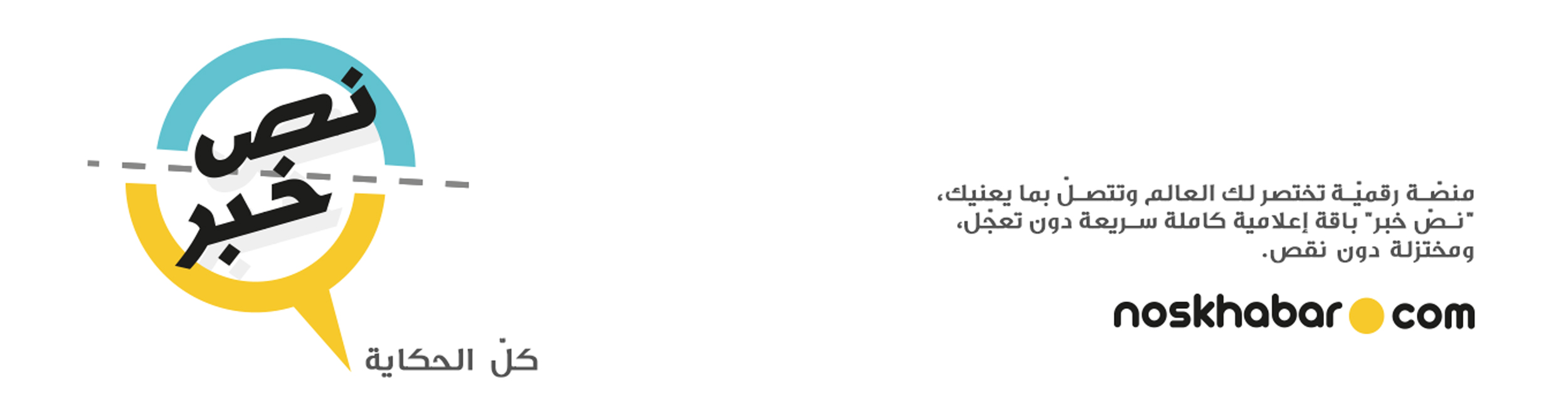7 فبراير 2024
ريم يونس – كاتبة أدب أطفال سورية
مهنتي هي اللعب
في برنامج تلفزيوني عن أشخاص قرروا تغيير مهنهم، يسأل المذيع سؤالاً عن الروتين اليومي الذي كان يقوم به الحاضرون، ويجيبون بالتتالي، وللصدفة يبدأون أجوبتهم ب “كل يوم أبدأ العمل في مكتبي صباحاً، كل يوم أبدأ العمل في المعمل الساعة ٧ الخ..”
يكون بين الحضور طفل صغير مع والديه، وبطبيعة الحال لا يسأله المذيع. لكنَّ الطفل يقف ويقول بشكل عفوي: “كل يوم أبدأ باللعب عندما أستيقظ ولا أريد أن أغير مهنتي”
يختصر هذا الطفل شرحاً لكثير من الأفكار، فاللعب فعلاً مهنة الصغار المستمرة التي لا يستقيلون منها إلا عندما يكبرون.
دافع اللعب فطري
في البداية، إن دافع اللعب لدى الإنسان فطري، يستجيب إلى حاجة بيولوجية واجتماعية. تقول الدراسات أن الجنين في بطن الأم يحاول اللعب أيضاً، فقد يلعب بالحبل السري ويقوم بفتح وإغلاق قبضاته الصغيرة بحركات متتالية، عدا الركلات والتشقلب.
وعندما يولد الأطفال يستمرون بسلوك اللعب كما بدؤوه في الرحم، حيث أنَّ الطفل بعمر الأشهر يلعب بالأيدي والأصابع، ويحركها في كل الاتجاهات ويحاول التقاط الأشياء من حوله. من خلال هذه الحركات يقوم بالتفاعل مع البيئة واكتشافها فيصبح اللعب سلوكاً لصيقاً لعملية النمو عند الأطفال.
اللعب ودوره في تحديد المهنة:
يشرح غابرييل غارسيا ماركيز في كتابه (دليلٌ لتكون طفلاً) عن أهمية اللعب عند الأطفال في اكتشاف المهنة المستقبلية اللصيقة بشخصية الطفل. حيث أنه إذا وُضع أمام طفل مجموعة من الألعاب المختلفة، فسينتهي به الأمر بالبقاء مع واحدة منها والاستمرار باللعب بها والعودة إليها، يعتقد ماركيز أن هذا التفضيل ليس محض صدفة، بل يكشف في الطفل عن مهنة وقدرة ربما لا يلاحظها والداه الشاردان ومعلموه المتعبون.
إن الطفل يولد مع مهنته مع قدر من الموهبة التي تساعده. وما على الأهل والمربين إلا تهيئة الظروف الملائمة له وتشجيعه على الاستمتاع باللعبة التي اختارها بنفسه دون أن يجبروه على اللعب بغيرها أو تلقينه الخوف من اختياره.
يقول ماركيز: “أنتَ تولد كاتباً أو رساماً أو موسيقياً، وعندما تصل إلى المدرسة تكون مهيئاً بالفطرة لهذه المهن وغيرها دون أن تعرف”
الطبيعة، بيئة اللعب المُثلى للأطفال
بالتوازي مع الدافع الفطري لللعب، غريزة الطبيعة.
يقول إدوارد ويلسون وهو عالم الأحياء التطوري الأب في جامعة هارفارد: “لدى الأطفال غريزة البيوفيليا، ويعني هذا حب الطبيعة وأنه متأصل في جيناتنا”
استند المصممون المعماريون على مفهوم البيوفيليا في تصميم أبنية وبيئات تُعيد التواصل الفطري مع الطبيعة في السنوات السابقة. ولكن بالإضافة إلى المصممين المعماريين استند أيضًا على نفس النظرية كثير من التربويين والعاملين في دور الحضانة والمدارس، حيث يشرحون أن الصغار يشبعون حاجتهم للتعرف على بيئاتهم والاتصال بالعالم الطبيعي ويستخدمون اللعب لإشباع حاجتهم.
فيصبح اللعب والطبيعة ثنائياً مثالياً في العملية التربوية.
في الطبيعة يمتلك الطفل كل أدوات اللعب والخيال، العصي تتحول إلى سيوف وسهام، أوراق الأشجار تصبح أغطية للحصى النائم. وأما الحصى نفسه فيصبح كائنات لديها عائلات وأولاد وأصدقاء، وقد يغضب الطفل من الوردة التي قطفها لأنها لم تلتزم بقواعد اللعبة التي وضعها.
كل هذا الخيال الساحر يحدث فقط عندما يلعب الأطفال لعباً حراً في الطبيعة.
كرم الطبيعة بتقديم كل هذه القطع الفضفاضة من عصي وحصى و تراب ورمل تجعل من الطفل مبتكراً، تمنحه القدرة على تطوير مهاراته ومعالجة مشاكله، فعندما تسمع حوار الطفل الذي يجلس يلعب بالتراب ويراقب حركة النمل، سنعرف بماذا يفكر أو ما الذي يحبطه حتى، سيلعب بشكل عفوي دور الدعسوقة الغاضبة أو النملة المحبطة من والدتها والتي منعتها من الحلوى.
اجلس واستمع وراقب كيف يلعب الأطفال وستكتشف أن ممارسة اللعب الحر يساعدنا نحن الكبار في رسم صورة واضحة عن المشكلات التي يعانون منها وبالتالي يسهل التعامل معها.
ولكن أين نحن من ذلك اللعب الحر الذي توهبه الطبيعة للأطفال بالمجان؟
في زمننا زمن ضغطة زر، حيث أصبح فيها الطفل متفرجاً على العالم وعلى لعبة تتحرك ألوانها أمامه على الشاشة، دون أن يتفاعل معها إلا بحركة عيونه؟
عندما ندخل أي مول تجاري ضخم نجد مساحة مخصصة للأطفال مليئة بالألعاب والمكعبات الضخمة، مليئة بالأدوات المُصنّعة والمطاطية، يحتار الطفل بنفسه أين يذهب في هذه المساحة البلاستيكية وفي ظل هذه الكَثرَة المبالغ فيها.
ونلاحظ أن ما يميز أماكن اللعب التجارية ألوانها الفاقعة وغير المتجانسة. إن هذه الألوان تتناقض بشكل كبير مع الطبيعة الحقيقية بألوانها المحايدة، في الطبيعة تكون الألوان ذات إطار موحد باللون البني أو البيج أو الأخضر، ونجد ومضات من الألوان على شكل زهور وفراشات وطيور. الطبيعة تؤهل مقدرة الطفل على الملاحظة دون عناء، وكأنها تلعب معه لعبة الاختباء وتقول له: “تعال اكتشفني!”
فعندما يسير طفل على طريق من الرمال ويرى فجأة خنفساء صغيرة، سيقف عندها ويركز نظره فيها يراقبها.
وعندما يمشي في حقل أخضر سيناديه طنين نحلة على زهرة صغيرة صفراء، هذا الصمت الذي تمنحه الطبيعة يشكل نقيض ما نراه وما ينتشر من ألعاب ذات أصوات حادة وضوضاء مصطنعة تزعج الكبير والصغير.
الكبار يلعبون أيضاً!
قامت الكثير من الشركات والمؤسسات في السنوات الاخيرة بإدخال اللعب إلى بيئة العمل. حيث زعمت نتائج التجارب مساهمة اللعب في كسر القيود النمطية في علاقات الموظفين وفي ابتكار الأفكار.
لكن منظومة رأس المال لم تُدخل أنشطة اللعب إلى مؤسساتها حرصاً على مشاعر الموظفين ومن أجل “سواد عيونهم” كما يقولون وإنما لتبقى نسب أرباح هذه الشركات في اطّراد متزايد!
لقد جعلوا من أماكن العمل المُرهقة متنفساً للموظفين حيث لا مبرر لديهم للمطالبة بزيادة الأجور والشكوى من ضغط العمل!
ماذا عن اللعب عند الحيونات؟
جاء في فيلم وثائقي على موقع ناشيونال جيوغرافيك أن اللعب عند الفقاريات قد يكون بنفس أهمية النوم. وأن العديد من الحيوانات تتعلم اللعب في صغرها ويستمر عدد منها باللعب حتى عندما يصبحون حيوانات بالغين، كالذئب والغراب والدلافين والقرد.
لكن لماذا تلعب الحيوانات وتستمر باللعب حتى بعد أن تبلغ؟
يقول خبير السلوك الحيواني مارك بيكوف إن أحد التفسيرات المحتملة هو أن اللعبة تساعدنا على توقع ما هو غير متوقع. عندما تلعب الحيوانات بمفردها، مثل الماعز التي تقفز وتهبط عمداً بشكل أهوج، فإنها تتعلم درسين: كيفية تصحيح أخطاءها وكيفية الحفاظ على هدوئها إذا حدث خطأ ما.
يقول بيكوف: “تمنحك الألعاب الفرصة لتعلم التعامل مع عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ في بيئة آمنة”.
وأما الذئاب فلعبهم مختلف، فهم يلعبون بحكمة وبشكل مدروس.
فقبل أن يتم ضم الذئاب إلى القطيع، يجب عليهم إثبات قدرتهم على اللعب. ولمنع تحول اللعبة إلى قتال حقيقي، يجب على الحيوانات أن تراقب عن كثب مشاعر خصمها في اللعب. يقول بيكوف: “جزء أساسي من اللعب الاجتماعي هو إعاقة الذات“. “وبهذه الطريقة، تتدحرج الحيوانات الأقوى على ظهورها لإعطاء الحيوانات الأضعف الفرصة لكسب اللعبة.” الهدف ليس الفوز بل إنه مواصلة اللعبة، ولهذا من الضروري خلق ساحة لعب قائمة على المساواة.
كنتُ أسمع هذا الوثائقي وأفكر “ألا يجدر بالإنسان مراقبة سلوك الحيوانات والتعلم منها لوضع منظومة أخلاقية جديدة تحاكي مستوى التوحش الذي وصل إليه؟”
أريدُ لعبتي!
بالعودة إلى الأطفال وألعابهم، تبين أنَّ الألعاب التي يخترعها الأطفال تعكس الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشونها.
لن نتوقع من الأطفال الذين يعيشون في ظروف الحروب أن يلعبوا لعبة الفراشات، بل إنهم بشكل فطري سيبتكرون لعبة تعلمهم مهارة مواجهة ماقد يحصل.
سُئِل طفل في غزة كان قد فقد جميع أهله
“ما الذي تريده؟”
شهق باكياً وقال “أريد ماما ولعبتي”
من المؤسف أن اللعبة الوحيدة التي أتقنها الإنسان بجدارة على مر التاريخ هي لعبة الحرب.
مواصلة اللعبة رغم تدمير الخصم!