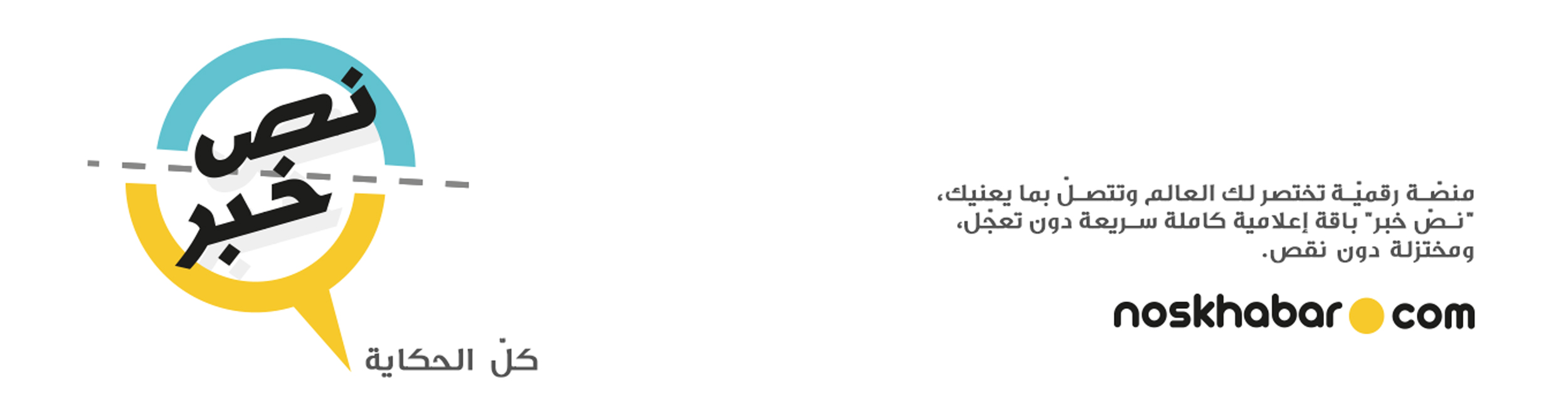28 ديسمبر 2023
حاوره: هاني نديم
يجمع د.مرسي عواد بين الأكاديمية والشعر، وهذا – من وجهة نظري – خطير إن كنت جاداً في الموضوعين. ولعل هذا تحديداً ما يجعلني ألتفت لكل حرف يكتبه د. عواد، بوصفه اليوم أحد أهم الأصوات الشعرية والنقدية معاً، ونموذج للمبدع المصري الذي اعتدنا عليه في منتصف القرن الماضي من موسوعية وإدراك ورصانة وتأثير. إنه جذوة إبداعية متقدة نستدل بها.
التقيت د.مرسي في دردشة سريعة حول الأكاديمية والشعر المصري وعنه خارج الكتابة، سألته:
- أبدأ من الأكاديمية وعلاقتها المربكة مع الشعر إن صح رأيي، فالأكاديمية تلبس بدلتها الكاملة والشعر مجنون عارٍ، كيف تجمع بينهما وكيف ترى المنهجيات النقدية العربية عموماً اليوم؟
– منذ أسابيع وأنا أضرب رأسي في طاولة الكتابة لأُنهِيَ بعضًا من المهام الأكاديمية العاجلة لعلِّي آوي إلى رُكنٍ في حُجرتي أفترش فيه الأرضَ وأخلع نظَّارتَي البحث والتدريس لأَفرُغَ إلى صوتي الأقرب.. من غير أن أُفارِق نُوتَتي مُتعدِّدةَ الأصوات.
هل أقول لكَ إن جذوة الشعر لا تتقدّ وسط “صقيع الأكاديميا”- كما تقول تلك القوالبُ الفكريَّة الشائعة؟ رُبَّما! رُبَّما جَفَّ مِدادُ قلمي بعد نهارِ-بحثٍ طويلٍ (زاخرٍ بالشَّغَف والمتعة)، فلم أستطعْ ليلًا أن أنثالَ على صفحتي الخضراء التي اختارَتْها طقوسُ القصيدة، لكنَّني درَّبتُ صوتي -إجبالًا بعد إجبالٍ- على أن يفيد من الصَّمت أكثر مِمَّا يربح من الكلام.
ولأنَّني أحد هؤلاء المُتألِّمينَ لوَقْع نِعالهم على خَدّ التُّراب، أُوثِر ألَّا أُضِيفَ إلى الطريق حوادثَ وخساراتٍ كثيرةً، وأن أكتفيَ بالأقلّ: أَثَرٍ يبقى، أو لافتةٍ تُضيء من بعيدٍ، أو جَرَّةِ ماءٍ تندى لترويَ عابرَ سبيلٍ رُبَّما تشابَهْنا أنا وهو في الطريق واختلَفْنا في الخسارات..
على أرضيَّة حُجرتي نُشارةٌ، وعلى المقاعد والطاولات نُشارةٌ، وفي حِجْري نُشارةٌ، ومن بين أصابعي وشَفَتَيَّ تسقط نُشارةٌ… نُشارةٌ أعفّ عن أن أحشوَ بها أفواهَ المطابع أو أن أُسمِّيَها قصائدَ ودواوين أضع اسمي عليها. ولو عَنَّ لغيري شبيهُها أو بعضُه، لطار بها على جناح جائزةٍ أدبيَّةٍ ضخمةٍ تظلّ تَجثم على اسمه حتَّى ليوشكَ أن يتلاشى الاسمُ والمُسمَّى تحتَها ولا يبقى إلَّا الجائزة. لا بأس؛ لي أن أفرحَ أنا والحقيقيونَ بالحقيقيينَ، ولنا جميعًا أن نحتفيَ بما نستبقيه بعد النُّشارة.. وقد صارَتْ أسماؤنا خفيفةً من الألقاب.
في البداية كنتُ أنفر من لقب الدرجة العلمية حين كان أحدُهم يَغمِزني به وهو يُقدِّمني شاعرًا، ثُمَّ بعد استماعه لنصوصي لا يلبث أن يستثنيَني من “الشعراء الدكاترة” كأنَّه يمسح عنِّي الغبارَ الذي ألقاه على اسمي أوَّلَ الأمر! كانت الدرجةُ العلميةُ في الحالينِ البديلَ الشاعريَّ لطريقة التشويش التلفزيونية على السِّباب والشتائم، ولم أكن أدري أيهما الأقذع.. هل حين استعملَ درجتي العلمية لوصفي في غير سياق النقد والعمل الجامعي، أم حين انتزعَها مِنِّي وهي حقٌّ أصيلٌ يُضِيف إليَّ كما أُضِيف أنا إلى دوائر استعماله، في غير افتتانٍ باللقب ولا ارتكانٍ إلى سطوة هالته في النفوس، لا سيَّما وأنا -بطبيعتي- مُتمرِّدٌ على “رِبْقة” العنق الأكاديمية “وأَكرهُ أن أُحِبَّ اسمي المُكفَّنَ في قميصِ نُعوتْ”.
في البداية كنتُ وكانت السياقاتُ كذلك، لكنَّني سرعانَ ما أدركتُ الجوهرَ حين آنستُ هذه النارَ التي صَهَرَتْني سبيكةً لا تنفصل بعضُ عناصرِها عن بعضٍ، وعناصرُها كلُّها كريمةٌ، لم يَزِدْها اجتماعُها وتمازجُها إلَّا أصالةً وخصوصيَّةً. صحيحٌ إنَّ للشعر -الذي بدأْتُ معه وأنا ابنُ عشر سنينَ- النَّفخةَ الأولى في أتون التجربة وإنَّ ضرباتِ يَدِه قد شَكَّلَتْ صلصالي الأوَّلَ الذي يُسمُّونَه “اللاوعي”، لكنَّ اشتغالي بالنقد والتَّرجمة وعلوم اللسانيات وما يتَّصل بها من معارفَ وعلومٍ باللغتينِ العربية والإنجليزية قد شَيَّدَ لي بيتَ النَّار أو تلك المحرقةَ الجبَّارةَ التي تُسمَّى “الوعي”، حيث أُدخِل صلصالَ اللاوعي ليَنضَجَ.. أو لتأكلَه النَّارُ وتتفُلَه نُشارةً لا تليق بي ولا بمعدن سَبِيكتي. لا أودُّ هنا أن أستعيرَ فَمَ (بودلير) لأُوضِّحَ ما عنيتُه في الأعلى بـ “النُّوتة” التي تنتظم فيها أصواتي العديدةُ فأقولَ “إنَّ المُبدِعَ كائنٌ أوركستراليٌّ”، بل أقول: أنا الكائنُ السَّبيكةُ… أنا شَغَفي. قصيدتي تُفكِّر.. لا تُثرثِر. لا أدري لِمَ عليَّ أن أدخلَ بنِصْفي “معركةً” ضدّ نصفي الآخر، أو كيف يختصم بعضي بعضي.. وكل شِقٍّ يُعطي شِقَّه كما يأخذ منه!
لا أدري لِمَ عليَّ أن أدخلَ بنِصْفي “معركةً” ضدّ نصفي الآخر، أو كيف يختصم بعضي بعضي.. وكل شِقٍّ يُعطي شِقَّه كما يأخذ منه!
ومن هنا، أرى أيضًا أن “معركتنا” العربية لإنجاز نظريةٍ نقديةٍ خاصةٍ تقوم على مفاهيمنا المُتجذِّرة في الدراسات البلاغية القديمة مع الإصرار على استبعاد مفاهيم النظرية الغربية وتطوُّراتها معركةٌ صبيانيَّةٌ تُحرِّكها “الغيرةُ- مِن”، وإن ادَّعى أصحابُها “الغيرةَ- على”.
المعارف والعلوم -مثلها مثل الآداب والفنون- عالميةُ التَّوجُّهِ، ومِن المُكابرة والسُّخْف أن نفتعِل صراعًا ننقسم فيه إلى فريقينِ: فإمَّا إلى المُحافظينَ “الغيورينَ على” الهُويَّة العربية، وإمَّا إلى المُتحرِّرينَ السَّاقطينَ في أحضان الغرب. الناقد باحثٌ ومُثقَّفٌ كبيرٌ، أو هكذا ينبغي له أن يكون؛ ومِن ثَمَّ، ينبغي له أن يَنفتِح على الآخر، من غير أن ينسلخ من ذاته أو يمسخ هُويَّتَه، فلن يُغبِّش ذاكرتَنا العربيةَ اطلاعُنا على المُنجَز النقدي في العالَم، ولن تمحوَ أسماءَنا العربيةَ معرفتُنا بمُنظِّري الغرب وأعلامهم. “أنا”-الناقد العربي -التي شَغَفَتْها رموزُنا الشاهقة في مدونة النقد العربي- لا ينبغي لها أن تستشعر الحرج وهي تُجرِّب أدواتِ النُقَّاد الغربيينَ أو تُحاوِل بعضًا من منهجياتهم. بل، قد يكون من الوجب على بعضنا -أو لنَقُلْ إذا شئتَ “فرض كفايةٍ”- أن نُضِيف إلى إرثنا النقدي العظيم إضاءاتٍ لسانيةً وفلسفيةً معاصرةً وحديثةً، لا لنستبدلها بشموس عصورنا النقدية، ولا لنحجب بها سواطعنا الخالدة، وإنَّما هي مثل النبتة التي نستحسنها من نبات الجوار فنُخصِّبها ونسهر عليها لنستنبتها في بستاننا إلى أن تَتجذَّر وتَسمُق، فلا تكون هي زرعًا شيطانيًّا ولا نكون نحن عالةً على أهل الجوار.

الحضارات تتلاقح، قويها وضعيفها… كبيرها وصغيرها، حتَّى مع احتدام الصراعات الإيديولوجية القديمة والصدامات الثقافية الحديثة، ومع ما قد يشوب ذلك أحيانًا من وَلَع المغلوب بتقليد الغالب، سواء اتفقنا كليًّا أم اختلفنا مع (ابن خلدون) و(صمويل هنتجنتون Samuel Huntington).
وهذا المشهد العام المُقارِن ينطوي على مشهدٍ خاصٍّ لتفاصيل المنهجيات النقدية العربية، بل والغربية أيضًا. فربَّما، بشيءٍ من التعميم المُخِلّ، يُمكِننا أن نُصنِّف تيارينِ كبيرينِ تتشكَّل فيهما الموجاتُ النقدية المختلفة. أوَّلهما يقوم على مرجعياتٍ نظريةٍ واضحةٍ ومُحدَّدةٍ سَلَفًا، تستقي أدواتِها من البلاغة واللسانيات، أو تتوسَّل بالمفاهيم التاريخية والاجتماعية والنفسية والفلسفية وغيرها، رافعةً شعار الموضوعية ومترفِّعةً عن اليقينيات بالاحتراز في التحليل والنتائج. وثانيهما يحدوه توجُّهٌ عامٌّ يغلب عليه الحَدْسُ والذاتيةُ من البداية حتى النهاية، في “سيولةٍ” منهجيةٍ (كثيرًا ما تنجرِف بالأداء النقدي عند بعض النُّقَّاد!) يَسُوقها ويُسَوِّقها الناقدُ/المُفكِّر ذو الهالة الكبيرة والامتلاء الذَّوْقيّ الأخَّاذ (أو -رُبَّما- تَوَهُّم الامتلاء؟). وأنا أُسمِّي التيارَ الأوَّلَ “التيارَ العِلْميّ”، حيث الانضباط المنهجي الذي قد يصل إلى حدّ “الصرامة”؛ وأدعو الثانيَ “التيارَ المعرفيّ”، حيث المرونة المنهجية.. أو اللامنهجية (؟).
المنهج جوهرٌ، لكنَّ التصريحَ به أو -بالأحرى- التلبُّثَ بعَرْضه وتفصيله في كتابةٍ تطمح إلى الجماهيرية لَغْوٌ!
فكثيرٌ من الممارسات النقدية التي يُقدِّمها النُّقَّاد غير المُتخصِّصينَ وعددٌ من الدراسات التي يُغامِر فيها النُّقَّاد المُتخصِّصونَ تحت مُسمَّى التجديد اليوم؛ تندفع مع تيار “النقد المعرفي”. ومع إنَّها تُصِيب أحيانًا، فيلتقط بعضُ أصحابها بعضَ اللآلئ، فهي تظلّ غالبًا عالقةً في الزَّبَد.. الذي يذهب بها جُفاءً. ولا يعني هذا أن دراسات “النقد العِلْمي” مُنزَّهةٌ عن الزَّلَل أو أنَّ نتائجها دائمًا عظيمةٌ؛ فمسالب النقد الأكاديمي الذي ينتمي إلى هذا التيار -على سبيل المثال- لا تخفى على أحدٍ، حتَّى إنَّه صار سُبَّةً صريحةً لا تصلح معها أي محاولةٍ من محاولات التشويش التليفزيوني.
لا أقول إنَّ المشهدَ النقديَّ في العالَم العربي اليوم مُظلِمٌ، ولكنَّني أقول إنَّه لم يَعُدْ ساطعًا قدرَ ما كان قبلًا. وإذا أردنا حقًّا أن نُسوِّغ النقد للجمهور أو -على أحسن تقديرٍ- للقارئ المُثقَّف غير المُتخصِّص، فنحن نحتاج إلى الموازنة بين التيارينِ، مع اعتبار ما يُمكِننا أن نترخَّص فيه من غير أن نخسر جوهر الممارسة النقدية. وفي رأيي، المنهج جوهر، إذ “الثروات الحقيقية هي المناهج” حسب تعبير (نيتشه)؛ وغياب المنهج سقوطٌ وشيكٌ للبنية الفكرية والتعبيرية وغيابٌ باتٌّ لمعياريَّة الحُكْم ولإمكانية التقويم، فإزاء أخطاء (ديكارت) ومغالطاته المنطقية -مثلًا- نجد (فولتير) يسخر منه ومن منهجه فيقول: “لقد أخطأ (ديكارت)، لكنَّه أخطأ بطريقةٍ منهجيةٍ”، كأنَّ إحسانَ (ديكارت) كلَّه مُقصورٌ على إدراكه لخطورة المنهج ومكانته الجوهرية في معالجاته، بصرف النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع أفكاره ومنهجه. في رأيي، المنهج جوهرٌ، لكنَّ التصريحَ به أو -بالأحرى- التلبُّثَ بعَرْضه وتفصيله في كتابةٍ تطمح إلى الجماهيرية لَغْوٌ.
ومع ذلك، فتطبيق الأمر عمليًّا ليس يسيرًا كما قد يبدو من الحديث. ويكفي لنُدرِك المشقَّة أن نعرف أنَّ نقاشاتٍ مثل هذه قد رفدَتْ نظريةَ المعرفة وفلسفةَ العِلم بموضوعاتٍ جديدةٍ حول تداخلات التخصُّصيّ واللاتخصُّصيّ وكيفية التمييز بينهما هما وغيرهما من المفاهيم القريبة المُتشابِكة. وقد حاولتُ جذب الانتباه إلى أهمية ذلك حين ترجمتُ مع فريقي كتابَ المعرفة المُستدَامة: نظرية في الدراسات البينية Sustainable Knowledge: A theory of Interdisciplinarity على أمل أن يُضِيف الكتابُ إلى المكتبة العربية في بابه.
هكذا، يا صديقي، يتداخل الأكاديمي والشعري ولا أستطيع فصل أحدهما عن الآخر.
تدري، الآنَ -فحسبُ- فهمتُ لِمَ خُيِّلَ إليَّ وأنا أقرأ صدر سؤالكَ هنا أنَّك وصفتَ علاقة الأكاديميا بالشعر بكلمة “المُركَّبة”، لا “المُربِكة”!
الغزارة الشديدة في الشِّعر والشُّعراء صِحِّيَّةً على المدى البعيد إذا أسفرَتْ عن أصواتٍ حقيقيةٍ مُميَّزةٍ، لا نُسَخٍ شائهةٍ عن أصولٍ غَفَلَ الضوءُ عنهم.
- كما أعتقد، لم يكن المشهد الشعري المصري مزدهراً أكثر من اليوم، هل توافقني؟ كيف تقرأ المشهد الشعري المصري اليوم؟
– أخشى أن أوافقكَ فحسب بدافع المحبة، يا صديقي..
لذا، فلتكنْ “نعم” ولكن محترزة قليلًا.
لا أملك إجابةً قاطعةً على مقارنة الحال اليوم بما كان قبل ذلك، لا سيَّما إن كان “الازدهار” هنا كيفيًّا وليس كمِّيًّا. إنَّ الشِّعر في (مصر) وفي الوطن العربي كله في حالة نشاطٍ وغزارةٍ لافتةٍ، إذ النصوص التي تُوسَم “بالشِّعر” اليوم كثيرةٌ للغاية، و”الشُّعراء” أكثر مِن أن يُحصَوْا، لكنَّ المستويات مُتفاوِتةٌ تفاوتَ السماوات والأَرضِينَ، والأصوات “المصرية” التي تدلّ على أصحابها وعلى ثقافتهم وبيئتهم ووسطهم الإنساني المحلِّي والعالَمي ضائعةٌ ضياعَ صرخة المصري المأزوم بواقعه وسط زحام (مصر) الذي يملأ ما بين السماوات والأَرضِينَ. الوسائط الجديدة على مَنَصَّات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية خَلَقَتْ حراكًا غير مسبوقٍ.. نعم، لكنَّها خَلَّفَتْ مُسوخًا كثيرةً. ورُبَّما تكون الغزارة الشديدة في الشِّعر والشُّعراء صِحِّيَّةً على المدى البعيد إذا أسفرَتْ عن أصواتٍ حقيقيةٍ مُميَّزةٍ، لا نُسَخٍ شائهةٍ عن أصولٍ غَفَلَ الضوءُ عنهم.

ولعلّي أكون أكثر تركيزًا وصدقًا في ملاحظاتي لو قصرتُها على الشعراء الشباب وواقع المشهد الشعري المصري اليوم. فمن العلامات الصِحِّيَّة أنَّ لدينا في (مصر) اليوم أجيالًا شعريةً عديدةً وأنَّ الشُّعراء الشباب أكثر حضورًا في المشهد أحيانًا كثيرةً. فتمثيلهم على المَنَصَّات الإلكترونية أقوى، والرَّوَاج الذي يُحقِّقونَه أكبر -رُبَّما؟- من الأصوات الأهم في الأجيال السابقة. فبوعيٍ أو بلا وعيٍ منهم، صنعوا لجيلهم دائرة الضوء التي يحتاجونَها حين انخرطوا في تزكية بعضهم بعضًا بالشكل الذي جعل صفحاتهم -على كثرتها وكثرتهم- نوافذ تسويقيةً تفرض ذائقة أصحابها يومًا بعد يومٍ. ثُمَّ نقلوا هذا الحضور إلى الواقع الأدبي، فشَكَّلوا دوائر ثقافيةً جديدةً شملَت الصالونات الأدبية والفعاليات الشعرية المُقتصرة -في غالبها- على الأقران في جيلهم، إضافةً إلى القليلينَ من الأجيال السابقة مِمَّن يَتوسَّمونَ فيهم الدَّعمَ.
ولو لاحظنا، فقد انشغل النقد المصري مؤخَّرًا بالسرد؛ إمَّا لأنَّه أكثر رواجًا، وإمَّا لأنَّ عددًا من النُّقَّاد المصريينَ ينظرونَ إلى الشِّعر المصري الآن باعتباره الأقلّ عُمقًا والأكثر شكلانيةً بين الأجناس الأدبية التي يكتبها المصريونَ، وإمَّا -حسب الرأي المُناهِض- لأنَّ الشِّعر أصعب من أن يقف على مكنوناته ناقدٌ من نُقَّاد “القراءة الموضوعاتية” العامة أو التهويمات الجاهزة. وقد أدَّى ذلك بالشعراء المصريينَ الشباب إلى تُجاهل الآراء النقدية التي ترصد كتاباتهم بين الحين والآخر، والاستعاضة عن كل هذا بالمساندة التي يتبادلون فيها الأدوار وبانتقال بعضهم إلى كرسيّ النَّاقد -سواء امتلكوا الأدوات النقدية الحقيقية أم لم يمتلكوها- ليُحقِّقوا هم كفايتَهم وليُحكِموا إغلاق دائرة الضوء على أنفسهم. ومع ما في هذا التوجُّه من “عدالةٍ أدبيةٍ/*شعريةٍ poetic justice” رَدَّ بها جيلُ الشعراء الشباب على التجاهل ومحاولات التقليل من شأنهم بالتجاهل المُضادّ “والاكتفاء الذاتي”، فقد خسرَ المشهدُ الشعريُّ المصريُّ الكثيرَ بغياب التواصل الفاعل بين الأجيال الشعرية المختلفة.
لقد أَضَرَّت المَنَصَّات الإلكترونية بالمشهد الشعري لأنَّها سرَّعَتْ وتيرةَ “الاستهلاك القرائيّ
وبسبب القطيعة التي يُعلِنها الشعراء الشباب مع الأصوات والأجيال التي سبقَتهم، تحوَّلتْ كتاباتُهم إلى ما يُشبِه التيار الشِّعري المُضادّ. فبَرَزَ ضمن السمات الموضوعاتية ارتدادُ البعض إلى الذات وغرقهم في تهويمات البوح، حتَّى طالتْ القصائد التفعيلية في غير إحكامٍ لبِنيتها السردية، في حين لجأ بعض شعراء القصيدة البيتية إلى تحجيم غنائيتهم في قصائد قصيرةٍ تعتمد فَنِّيًّا على تشقيق الصورة الشعرية وتستبدل ببلاغة الحقيقة والصورة البسيطة بلاغةَ المجاز والصورةَ الذهنيةَ المُركَّبةَ. وكان هدفُ هؤلاء وهؤلاء تفاديَ التكرار في الموضوع والمعالجة الفنية، إلَّا أنَّ التكرار قد وَصَمَ غالبهم. ثُمَّ إنَّ انغلاقهم على أنفسهم قد حرم بعضهم من تطوير تجاربهم وتعميقها، كما أنَّ قربهم الشديد وانكفاءهم على التجارب التي تُشبِههم قد انعكس على بعض إنتاجهم، فتشابه إلى حدّ التناسخ (أو التماسخ؟). فالعبارة الفرنسية “Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es” “قُلْ لي ما تأكله، أقلْ لك مَن أنت” قد ألقَتْ بظلالها المجازية على كل شيءٍ حتَّى صارتْ في الإنجليزية “You are what you read” “أنت هو ما تقرأه”. وأصدقائي هؤلاء يظلمونَ أنفسهم ويُضيِّعونَ على المشهد الشعري المصري فرصة ثرائه النَّوعي بالاحتباس داخل تجاربهم الضَّيِّقة المكرورة وبتدوير اللغة والموضوعات والمعالجات ذاتها بينهم.
لقد أَضَرَّت المَنَصَّات الإلكترونية بالمشهد الشعري لأنَّها سرَّعَتْ وتيرةَ “الاستهلاك القرائيّ”، فسَرَّعَتْ وتيرةَ “الإنتاج الكتابيّ” الذي تَضَخَّم في الكَمّ على حساب الكَيْف والجودة النوعيَّة. ولمَّا عَثَرَتْ بالكثيرينَ قرائحُهم، انزلقوا إلى التَّكرار؛ فبات لشاعرٍ دون الخامسة والعشرينَ بضعة دواوين، رُبَّما لم يطبعْ مثلَها رائدٌ من رُوَّاد الشِّعْر العربي إلا بعد أن بلغ الأربعينَ أو الخمسينَ من عمره. ولا شكّ أنَّ الجوائز العربية الكبيرة-مالِيَّا لها دورٌ خطيرٌ في تحريك “سُوق تلك السِّلَع الوَرَقِيَّة” أو “تكديس منتجاتها وبَوَارها”، وإن كان لها الدور أيضًا في ترويج القصيدة البيتية وإعادتها إلى صدارة المشهد -ولو على المستوى الإعلامي في المسابقات والفاعليات الكُبرى- بعد أن كادتْ أصداؤها تخفتْ إلَّا بين مجموعاتٍ قليلةٍ من كل بلدٍ عربيٍّ.
المشهد الشعري في (مصر) وفي الوطن العربي -إذن- مُبشِّرٌ في غزارته، لكنَّه في حاجةٍ إلى “ترشيد الإنتاج” في الحاضر لتتحقَّق له “الاستدامة”.. أو فلندعِ الأمرَ ليَدِ الزمان لعلَّها تُخلِّد بحكمتها مَا يستحق وتسحب الذيلَ على ما دون ذلك.. أو فلتكنِ التصاريف وعجائبها.

- عن شخصكم خارج الكتابة، حدثني عن عملك وأحزانك وأفراحك وعن الأصدقاء والأغاني والناس
– في الكتابة وخارجها (إن كان ثَمَّ مكانٌ خارجها؟)، أجد متعتي الخالصة في القراءة.
لذلك، أتورَّط كثيرًا وأنا أقرأ في موضوعات البحث أو التدريس، فأتوسَّع حتَّى لأكاد أحار إن كان الأمر نعمةً أم نِقمةً، لكنَّ الاختراع العبقري المُسمَّى “بالموعد النهائي لتسليم العمل dead line” يُلزِمني في النهاية بالإنجاز الذي يُرضيني ولا يُحزِنني على الجهد والوقت المبذولَينِ بسخاءٍ.
ولولا الأفلام والسلاسل الوثائقية، وأغاني (أم كلثوم) و(فيروز)، وأهازيج المديح والإنشاد الديني الشعبية التي أهنأ بها جميعها كلَّما شعرتُ بالإرهاق من القراءة هنا وهناك، لحسبتُ أنَّني كائنٌ وَرَقِيٌّ لا تَشعَفني المتعةُ الأرضيةُ.
وإنَّ من لحظات فرحي الحقيقية أن أرى تلاميذي المجتهدينَ وهم يتطوَّرونَ، فيُناقِشونَني مناقشة الأقران أو -حتَّى- الأنداد.
أمَّا حُزني، فعلى القيمة التي تهوي كلَّ يومٍ بين أروقة الجامعة وعلى المَنَصَّات الأدبية والثقافية وفي شوارعنا وبيوتنا حين تَتَغَوَّل ثقافة “الاستهلاك takeaway”.
ثُمَّ أعود وأقول لعلّ في حزني -أنا والأصدقاء- عليها وحرصنا على قذف حجرٍ في الماء الراكد عزاءً وأملًا.