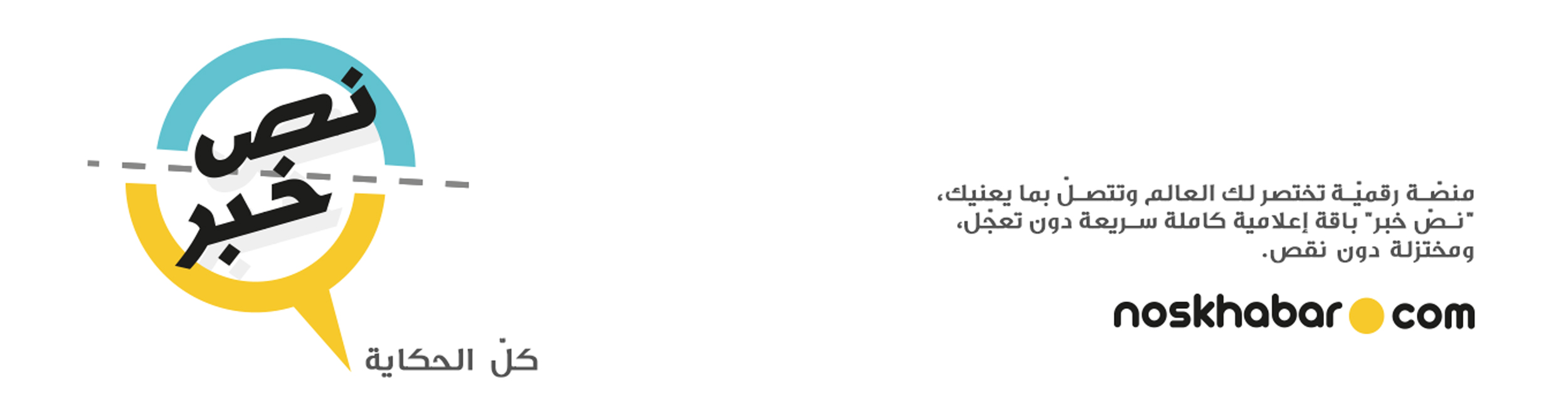كلما قرأ الشاعر اللبناني حسن المقداد قصيدة، سمعت في خلفيتها دبكات وأنغام البعلبكيين وشممت رائحة أحجار المعابد التي ما تزال تذكرنا بتاريخها المجيد. لا أعرف حقاً سبب هذا التداعي الذي يتلبسني وأنا أسمعه يلقي، إلا أنني أكيد من نصه الخاص ومعجمه الساحر، وأكيد أنه من الأصوات التي تعمل بجدية وحساسية استثنائية. تأجل هذا اللقاء بسبب الحرب في بلادنا الحبيبة.. ولكن لا بد من نشره ولا بد من تعزيز ثقافتنا العربية في كل وجوهها..
التقيته في هذه الدردشة الخاطفة بين نصيّن.. سألته:
- من البدايات.. كيف كتبت أول قصيدة، وكيف كتبت آخر قصيدة، لنتحدث عن السيرة الذاتية لنصك، ملامحها ومنعطفاتها.. هذا ملهم.
ما زال في بالي صوت جدّي الطافح شجناً وهو يغنّي العتابا “فراقيات” على الطريقة البعلبكيّة
- لا بد لي من السؤال عن بعلبك الشمس والمواويل والأهازيج، ماذا أخذت منها وماذا خليت؟

- برأيكم؛ هل بإمكان القصيدة أن تنهض دون المعارف والثقافات والعلوم المتصلة؟
يحرّكني إيماني بنفسي وتمسّكي بهويّتي وحبّي لهذه البلاد المنذورة للرسالة المسكونة بالمعجزات منذ فجر التاريخ
- عن حسن خارج الكتابة وداخل الحياة.. مباهجه وأحزانه، آمالك وأحلامك، الأصدقاء والبلاد والأغاني..