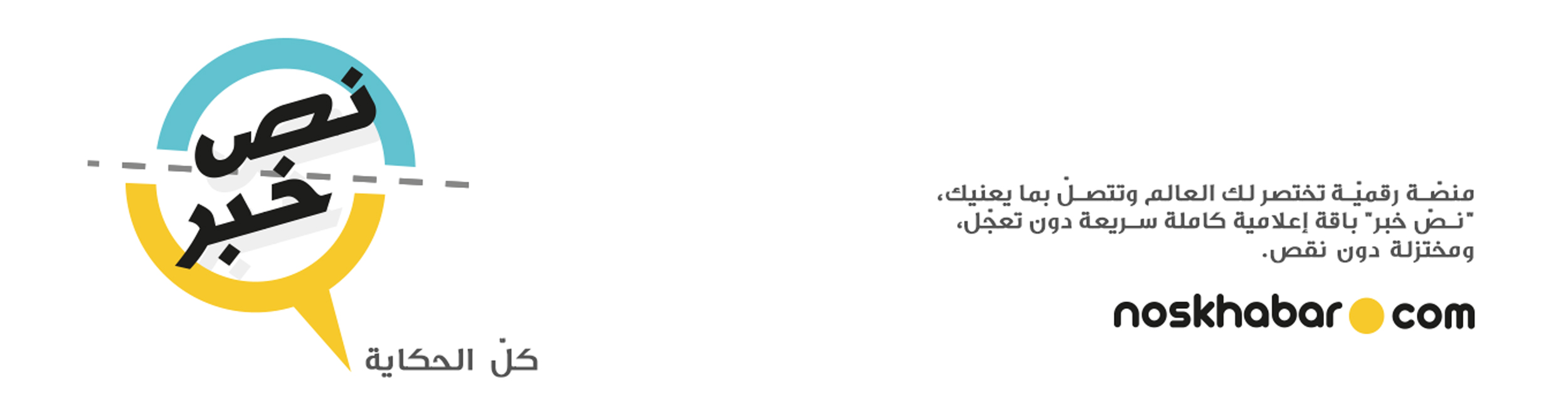30 يناير 2024
هنادي زرقة – شاعرة وكاتبة سورية
“انسينا…
لا تفكري فينا…
تعرّفي على ناس جدد…
عيشي حياتك”
كانت تلك كلمات صديقي الشاعر منذر مصري وهو يحثني على المضي في برلين, في اللحظة نفسها عبرت ذاكرتي كلمات ألفريدو في فيلم سينما باراديسو التي قالها للصغير تيتو: “لا تغرق في الحنين للماضي, انسَ كل شيء”.
هل النسيان قرار يذهب بكبسة زر؟ ثم لماذا عليَّ أن أنسى؟
تقول صديقتي وقد لاحظت انشغالي الدائم بالردّ على الرسائل التي تصلني من سوريا: “You can not live in two places”, خففي قليلاً من ارتباطك بسوريا إن كنت تريدين البقاء هنا!
لطالما حاولتُ منذ قدومي هنا أن أتجاهل كلّ ما يؤلم قلبي من ذكريات وأغانٍ وحتى طعام. قلتُ: سوف أركّز في المكان الجديد وأتعلم لغته وأخترع ذاكرة جديدة لأماكن وأغانِ جديدة إسوة بكثيرين سبقوني. بيد أنني لم أفلح! وكلما عاتبني أحدهم على إفراطي في الحنين أجبته: لقد غدا عمري خمسين, يشبه الأمر اقتلاع شجرة زيتون معمرة وغرسها في مكان جديد, ثمة أشجار لا تستطيع مدّ جذورها في تراب جديد, وأخرى تتأقلم لكنها لا تكون بالإنتاجية نفسها, وأنا لا أعرف, حتى الآن, أي شجرة أنا.
أنا هنا, حسنُ, لأجرّب حياة جديدة.

أستيقظ في الساعة السادسة, الثامنة بتوقيت سوريا, أهرع إلى هاتفي وأرى آخر ظهور لأخوتي وأصدقائي على الواتس آب والماسنجر, “الجميع بخير” و هذه الـ”بخير” تعني أنهم على قيد الحياة وحسب, لكنهم ليسوا بخير! أخشى سماع أصواتهم أو رؤيتهم, أقول لنفسي “كوني قوية, لا تدعي الحنين يهزمك”. أتابع الصفحات السورية على الفيسبوك كي أعرف ماذا يتغير في غيابي, وفي مرات عديدة أعرف الأخبار قبل أن يعرفها أخوتي نظراً لانقطاع التيار الكهربائي الطويل في سوريا. أنهض وأعدّ القهوة ثم أجلس على الشرفة أراقب الصمت والأشجار العارية وسنجاب يصعد ويهبط دون كلل من دون أن يحظى ببندقة. ما من أحد يلوّح من شرفة مقابلة أو أغنية تنبعث من بيت, ما من ضجيج لأطفال يذهبون إلى مدرسة, وحدها الغربان تقطع صمت هذا الصباح.
لماذا أتحدث عن فترة الصباح؟
حدث ذلك منذ شهر, وأنا ذاهبة صباحاً إلى موعد هام, استقليت القطار وفي المحطة التي اعتدتُ فيها تبديل القطار والذهاب إلى موعدي انبعث صوت فيروز عالياً “بدّك لحبيبك تقطفي قمر.. رح يوصل حبيبك بكرا من السفر.. وجيرانك يحكوا معو…كيف الصبايا تجمعوا…لما كنت بالشجرة… وصرت تغني يا قمرة”, ومثل من يمشي في نومه تبعتُ الصوت, كان الصوت يجرّني خلفه إلى أن وصلت إلى كشك صغير. رأيتُ شابّاً ذا شعر أسود كثيف يشبه غابة, سألته: هل أنت عربي؟ أجابني: فلسطيني! وقفت في مكاني مثل من رشّوه بالفكستور, لا أعرف ماذا أقول, أغمضتُ عينيّ وسرحت في أقاصي الذاكرة.
كان ذلك في عام 1992, في سنتي الجامعية الأولى. كانت وسائل النقل قليلة جداً وكان علينا أن ننتظر طويلاً حتى نحظى بحافلة تقلّنا من القرية إلى مدينة جبلة ومن جبلة إلى اللاذقية, التجربة نفسها عشتها بعد عام 2011. ولكن دعونا نعود إلى عام 1992-1993, قال لي زملائي ثمة باص أخضر ينزل كل يوم من القرية إلى الجامعة وهو يتقاضى عشر ليرات وحسب, مبلغ زهيد إذا ما قورن بأسعار النقل هذه الأيام, عليكِ أن تنتظريه في الساعة السادسة والربع صباحاً. هكذا بدأتُ سنتي الجامعية الأولى, باص كبير قديم مكتوب على إحدى جوانبه “كلّ الخيل للخضرا عبيد” يكّدس الطلاب والموظفين والعسكريين وبعض الذين لديهم أعمال مبكرة ويقلّهم إلى اللاذقية. قلّما استطعت الحصول على مقعد كي أجلس فيه, لم أكن أتخيل يوماً أن القطارات في أوروبا تكدّس البشر بالطريقة نفسها. لماذا أتذكر ذلك الباص الأخضر؟ لأن سائق الباص كان لديه كاسيت وحيد لفيروز يضعه في المسجّل ويتركه طوال النهار, غير أن الغريب في الأمر أن كل أغنية تصدح في مكان معين, فعلى سبيل المثال: أغنية قمرة يا قمرة هي الأغنية التي أسمعها وأنا أستقل الباص من مفرق بيتنا, أما أغنية القمر بيضوي على الناس فهي الأغنية التي نسمعها عند الجسر القديم في مدخل القرية, وأغنية يمّا الحلو ناسي الهوا يمّا فكنّا نسمعها على مدخل اللاذقية. تتوالى الأغنيات والأماكن بالترتيب نفسه طوال عام. حتى كنّا نتندّر بالقول: من سينزل في موقف حبيبي بدو القمر؟ تُرى ماذا حلّ بأولئك الأشخاص الذين اقتسمتُ معهم ذلك الحيّز الضيق؟

تسرقنا فيروز من عزّ النوم, نعدّ قهوتنا ونجلس على الشرفات, نتبادل الأحاديث من شرفة لأخرى وصوتها يخرج من الشرفات والشبابيك إلى الشارع المحاذي لبيتنا, تنجدل أغنياتها بصباحاتنا حتى يغدو من الصعب فصلها عن بعضها, فجميع من في القرية يحبون سماع فيروز, يغدو الأمر كأنه طقس جماعي.
غدا سماع فيروز عسيراً في السنوات الأخيرة, كنت أهرب منها, ليس منها بالضبط, بل من تلك المشاعر التي تنتابني ما إن أسمعها, أهرب من ذاتي المهزومة كل صباح, أهرب من الخذلان في الحب ومن الوطن الضائع, من يديّ أمي, من الحرية! أهرب من أحلامي ومن كل ما يذكّرني بطفولتي البعيدة. بيد أنّ أيّ نقدٍ لأغاني فيروز أو السخرية من كلمات أغانيها كان يمسّني وأعتبر أن هذا النقد موجّه لي, كأنّ أحداً يطعن بتاريخي وبهويّتي.
يقول صديقي: “كفّي عن النوستالجيا, لا مزيد من أغاني فيروز أرجوك, قلبي يتشلّع مع كل أغنية أسمعها”.
أما صديقتي فتقول لي: لا أستطيع احتمال سماع أغاني فيروز في برلين, وتمضي لهدهدة طفلتها وهي تدندن من دون انقطاع “بردا بردا لي بردا عيني عيني بردا يما لي بردا وكرمال عينك يا ولفي سبع وردات بوردة…جانا المطر من قبلي والغيم لمّ طرافه وأنا مضيع وليفي بالصوت بالله من شافو”.
هكذا من دون أن نعي, دخلت أغاني فيروز في دورتنا الدموية, كأننا رضعناها من أثداء أمهاتنا, أمهاتنا اللواتي كنَّ يغنّين “يلا تنام … يلا تنام تدبحلا طير الحمام”. في دراسة أجرتها جامعة ميلانو, شملت تلك الدراسة 170 امرأة, ذكرت تلك الدراسة إن الأمهات اللواتي كنَّ يغنين لأطفالهنّ خلال فترة الحمل وبعد الولادة كانت فترة بكاء الأطفال أقصر بكثير من تلك الأمهات اللواتي لم يغنين.
أتساءل لماذا تطول نوبات بكائي على الرغم من أن أمي لم تبخل عليَّ بالغناء! ربما بسبب تلك التهويدة التي تغريني بذبح الحمام إذا نمت. بقيت هذه التهويدة سنيناً في ذاكرتي حتى خرجت نصّاً شعرياً “كان عليَّ أن أنام مبكراً كي لا يذبحوا الحمام….طرْ أيها الحمام…طِرْ أيها الحمام”.
أفتح عينيّ, ما زلت أمام الكشك الصغير, أنظر إلى اللوحة الالكترونية وأقرأ أسماء القطارات المغادرة. ياه…. لقد فاتتني قطارات كثيرة وأنا لا أستطيع مغادرة الأغنية! كيف يمكن أن أنسى؟ ولماذا عليّ أن أنسى؟
“الخفيف يذهب بعيداً
دون أن تتعب قدماه
لكن هناك أثقال القلب”.