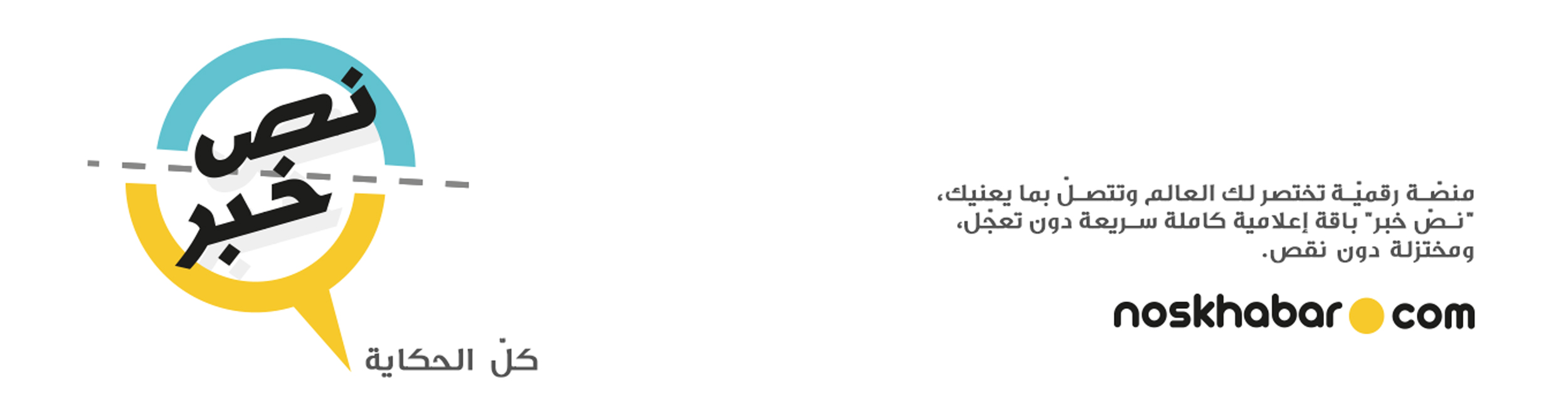2 مارس 2024
نص خبر – متابعة
كتب الناقد والكاتب عزت عمر عن زياد عبدالله الروائي والصحافي السوري المعروف:
يعود زياد عبد الله للكتابة في ما آلت إليه الأوضاع السورية بعد روايته الآسرة “كلاب المناطق المحررة” وليس ثمة ما يدعو للاستغراب بتسمية المجموعة “سورية يا حبيبتي” (منشورات المتوسط 2022) فهي حاضنة وأم كلّية.. الشام المباركة التي هاجرت منها الجماعات البشرية لتشكّل ممالكها وتؤسس ما نسمّيه اليوم العالم، ألم يقل أحدهم أنه لكلّ إنسان وطنان وطنه الأم وسورية؟ هنا إذاً أمّ كلّية ما زالت البشرية مربوطة بحبل سرّتها، وبذلك فإنها تستحقّ هذه التسمية وذلك النشيد.
توغل زياد في أعماقها ونبش مشكلة التعدّي عليها من قبل ذوي الرحم الاصطناعي ينشدون عسلها ولبنها، برّها وبحرها وسماءها حتّى الثمالة، لا بل طردوا أبناءها الطيبين، زارعو القمح الأوائل ومنتجو الخيرات ومبدعو الأبجدية، بحجج وذرائع شتى لا تخفى على أحد!
عن هؤلاء المفعمين بعبق الحقول والأرض الندية وطعوم الحليب كتب زياد مجموعته هذه ولأجل ذلك اختار شخصياته كنماذج يمكن ملاحظتها في الواقع، ففيهم البسيط النبيل والمثقف المبدع وفيهم الوطني الشريف، وفيهم من عاث فساداً وإرهاباً، والكتابة الإبداعية في هذا المستوى تغدو التزاماً ومسؤولية يتبناها الأديب برؤيته المتجاوزة للحالة الصراعية برمّتها تبعاً لم يستشرف نتائجها، ومن هنا فإن كتابة زياد لهذه المجموعة ليست لدوافع إيديولوجية أو سياسية متخندقة في جهة ما، وإنما تعبير عن رؤية فكرية وأخلاقية تشير إلى مواطن الخلل التي سببت هذا الطوفان.

ثيمة الغياب
في قصة “الطريق إلى حلب” نقرأ عن العجوز الحلبية “أم عمر” التي وجدت نفسها في ألمانيا هي المصابة بالزهايمر، وليس ثمة ما يعيدها إلى حلب سوى الرائحة، رائحة منزلها التي أبت أن تغادرها، وهذه العجوز أمّ طيّبة بدورها لا ترى أن الآخرين أعداء، وعلى مدار القصّة يتهيّأ لها أن هاته النسوة وأولئك الشباب هم أبناؤها، مشاعر الأمومة ذاتها انتقلت من حلب إلى ألمانيا، كيف ولماذا لم تبيّن القصّة سبب وجودها هناك بلا ذاكرة فذلك متروك للمتلقّي ليملأ الفراغ أو المحو، وعليه أن يتابع استعادة العجوز لبعض ذاكرتها وهي تعاين المكان والشخوص بمنطق الطفولة، وعليه أيضاً أن يتفهّم آثار الغياب المدمّرة للأنوثة كرمز للصبر وللإخلاص لمجموعة من النساء اللاتي اعتقل أو غاب أزواجهنّ عنهنّ لسنين طويلة بالرغم من ارتباطهنّ بالوطن كحاضنة أمومية، ولكنها في الوقت نفسه تجد نفسها في مأزق وجودي ناجم عمّا آلت إليه الأوضاع فيها، فتتعدد النماذج وتتنوّع الموضوعات ولاسيما موضوعة الغياب بسبب الاعتقال والموت فضلاً عن موضوعة الاغتراب الروحي ومعاناة الشخصية في المكان أو خارجه، كما في قصّة “مرسال الغرام” أو قصة “البطل” و قصته المثيرة لأسئلة محزنة وليس ثمة إجابات سوى ما استعرضه في “يا وردة الحبّ الصافي” أو “سنفور كسلان”.
كلّ قصة من هذه القصص تناولت الغياب وأثره البالغ في حياة الأسرة السورية ومحيطها وفي الذات الإنسانية عموماً، فالشخصيات في الغالب نلتمسها في حالة انتظار الغيّاب والآمال كبيرة في عودتهم سالمين، بما يشبه “انتظار غودو” ولكن الزمن يعصف بأمانيهم البسيطة فلا يتمكنون حتّى من السؤال عنهم، وهنا في هذه اللحظات الشديدة التوتر النفسي والعاطفي يحضر المبتزون الفاسدون من رجال الأمن وأعوانهم وأولئك الذين بالغوا في غرورهم الذكوري، كما في “مرسال الغرام” وهي قصة أشبه برسالة اعتراف يوجهها سارد القصّة لـ “نادية” زوجة المعتقل، وهي امرأة وحيدة تعدّ طعامها ثم تلتهمه ساهمة أمام التلفاز لا تعرف شيئاً عما يعرض حتّى أذان الفجر.
ويعتمد القاص في قصّته على الخطاب الموجّه المباشر كضرب فنّي لأجل التنويع في تقنيات السارد المختلفة من قصّة لأخرى وذلك وفق ما يأتي:
“قال لك كما في كل مرة بأنه سيعود، لكنه تجاوز الثلاث سنوات، وما من خبر عنه، إلا أن أمراً لم يتغير في مواظبتك على استعادته واستحضاره وإحيائه متى داخلتك شبهة بموت، وليبقى الغياب مصابك الخاص بك تماماً، ولك أن تخرجيه في كل لحظة وتنفضي عنه أي ذرة إهمال، كما لو أن غيابه حضور بحد ذاته، وهو يرافقك أينما ذهبت، جالساً بجوارك في السيارة، تقودين وتصلين وجهتك أنت وهو وغيابه.
لقد كنت مدهشة في تركيزك المطلق على غيابه، وعدم الاستسلام لغوايات التفكير بما أُلحق به من أذى. وهذا يتعدى مذاق اللوبياء، وكيف نجحت ببراعة أنثى خارقة بألا يختلط مذاقها بمذاق وحدة قاتلة، ومن دون أن ترشي عليها أياً من توابل الاشتياق الحارقة..”
ومثل هذا الاشتغال المتوغل في أعماق نادية لا نعرفه من خلال مونولوج كاشف لها، وإنما من مرسال الغرام ذاته، ولعلّه ضمير الكاتب ودقّة ملاحظته في تتبّع سلوك الشخصية النسائية وإقامة مقاربات مجازية وتشبيه حالة المرأة المنتظرة عودة الغائب بمن يحمل كيس الأمل كما يحمل المرء على ظهره كيس طحين، بل لعلّها في هذه الحال تشبه حالة بنيلوبي وخطّابها في “أوديسة” هوميروس ولكن أوديسيوس هنا لن يأتي لإنقاذها!
كان لخيورخي لويس بورخيس رأي حاسم في ثيمة “الغياب” إذ قال: “أن يكون المرء هو أن يُرى” بمعنى أن الغياب مشروط بالحضور وإلاّ لكان فقداً كحال نادية والأخريات ينتظرن عودة الغائب التي طالت كثيراً ومع هذا الانتظار تشتعل الذكريات ويبدع الكاتب في نصوصه: شوق للروائح، وآخر لملامسة جسد، للرؤية، للإصغاء، للوصل، للبكاء في أحضان مفتقدة في الزمان الجديد.. ولكن جملة هذه العوامل والزمن الممتدّ سنيناً قد يؤديان إلى تغيّر المشاعر تجاه الكائن الغائب، فهو قد لا يعود أبداً وهذا يعني أن الطرف المتضرر من هذا الغياب هنّ النساء زوجات في الغالب وأسرهنّ، كحالة نادية التي ما انفكّت تنتظره بينما يحوم حولها ممثلو الذكورة مرسال الغرام وضابط الأمن، ومثلها “ندى: في قصّة “يا وردة الحبّ الصافي” عن المرأة التي تعاني بدورها من غياب زوجها بينما جارها الطالب الجامعي وزميل ابنها سوف يعزو مشاعرها في الوقت الذي احتاجت فيه لصديق يحتسي معها فنجان قهوتها كدأب زوجها يوم كانا يستعمان لفيروز وهي تغني في صباحات الإذاعة السورية، إذ تقارن خلاصات هذه الأغاني مع ما آلت إليه أوضاع المدن السورية من هجران ودمار بسبب الحرب وتغوّل السلطة ورجال أمنها الفاسدين.

والقصّة في بنائيتها تنهض أساساً على المتفاعلات النصّية وأبعادها الدلالية القائمة في الذاكرة الجمعية، وهي في جانب آخر نوع من اللعب أشبه بلعبة “الروليت” الروسية حيث يراهن المقامرون على حياتهم، لكن المراهنة هنا على حياة المدن إن صحّت المقاربة، إذ إن ندى تسمع الأخبار وهي ممسكة بوردة تقتلع بتلاتها واحدة إثر أخرى كلّما ذكرت المذيعة اسم مدينة: مدمّرة أم غير مدمّرة؟ فنرى خارطة المدن السورية أشبه بالمدن الميتة التي هجرها أهلها من الحضارات السابقة كـ “إيبلا” و “ماري” وسواهمما، ولعلّ هذه المشاعر الفائضة الشفافية سوف تتجلّى واضحة من خلال المونولوج الطويل المعبّر عما يتفاعل داخلها من مشاعر متناقضة بدءاً من لحظة قبول زيارة “أمجد” لشقتها. وهي في الحقيقة قصّة بالغة العذوبة والشفافية السردية التي يتقن صناعتها مبدع حاذق أوصل رسالة لقارئه بما معناه أنه إذا كانت وردة الوطن جرداء وقبيحة إلاّ أن وردة “الحبّ الصافي” مورقة ودائمة الخضرة.
ولا يختلف الحال عن الشخصيات الذكورية، فهي بدورها عانت من الاعتقال من مثل سعد في قصّة “القرف” وهو مُعارض ومعتقل سابق، ولكن ليس للحدّ الذي يمكن اعتباره رمزاً، وإنما شخصية بسيطة ومغمورة نتابعها على شواطئ اللاذقية بعد الخروج من المعتقل.
في هذه القصّة يوظّف القاص الزمكان الخاص بها، شخصية مماثلة للعجوز الحلبية أم عمر وفي ذات الأجواء السريالية الشفّافة التي يمكن للقارئ اكتشافها من خلال السارد، وربّما بذات المنطق الأرسطي بمقدّماته ونتائجه للشخصية المهمّشة والمنكسرة في مواجهة واقع ضاغط سعى القاص للكشف عن مخبوءاته النفسية الكامنة التي داومت على إرسال نداءات استغاثة تماماً كتلك السفن التي تتعرض للمخاطر إبّان العاصفة الهوجاء كي يصل ركّابها إلى برّ الأمان، ومن هنا فإن القاص يبدع في استعراض أحوال هذه الشخصية المسماة “سعد”، ولكن لا سعداً بلغت ولا سعادة، ولعلّها ثيمة عامة تربط ما بين شخصيات القصّص كافة، وهم يواجهون مصائرهم خاضعين للمشيئات والضرورات العاتية، فمكّنت القاص من التعبير عن هذه الهشاشة الإنسانية بجملة من المفارقات السرديّة والتخييل الباذخ، بالربط المحكم ما بين معاناة الشخصية والانزياح البلاغي في رحلته اليومية لحماية السلاحف من الانقراض، وكأن هموم الدنيا قاطبة توقّفت عند حدود حماية السلاحف من التلوث البيئي، فضلاً عن التناص ومدلولاته في التطرّق إلى سيَر الناجين من الفيضان في سفينة نوح التي مكّنت ركّابها من الوصول إلى برّ الأمان وفق ما يأتي: “ومضى إلى ملاقاتهم كما لو أنه على موعد معهم، وبات سعد يفكّر ما إذا كان صديقه هذا الوحيد الناجي من بينهم، وأنه نوح بينما هو ورفاقه الآخرون نسل ضال لم يتسع له يوماً المركب..”
وسعد ورفاقه هنا هم ذلك النسل الضال باعتبارهم معتقلين سابقين، وهم الضحايا والشهود في الآن نفسه، وإن كان الاهتمام بالسلاحف الآن يشغلهم إنما بسبب اليأس وتلاشي الأمل ولم يبق سوى القرف جواباً على سؤال مفاده: “لماذا الآن تخاف ومن قبل لم تكن؟!
ومن الشخصيات البسيطة اختار القاص في قصّة “البطل” شخصية غير نمطية لبحّار سوريّ اختار الإقامة في نيويورك للفوز ببطولة العالم للملاكمة، وكأنما القصة أشبه بحلم طويل يسرده ملاكم حالم بهذه البطولة العالمية وكلّ ذلك لأجل أن يطلب من الريس عندما يقابله، أن يأمر بإطلاق سراح أخويه المعتقلين، لكنّ هذه الأحلام سرعان ما تبخّرت بالضربة القاضية التي وجهها له خصمه.
وهذه القصّة بدورها تعتمد المتفاعلات النصّية لإيهام قارئه بواقعية الحدث إذ تغدو “قاعة “ماديسون سكوير غاردن” المكان الافتراضي لجريان وتنامي الأحداث عبر ذاكرة الملاكم، فضلاً عن إدراج أسماء المدربين والتحدث إليه باللغة الإنجليزية في بعض الحوارات كتجريب إضافي ارتبط بنهجه الكتابي ما بعد الحداثي.
ومن الشخصيات النمطية نقرأ قصّة “سنفور كسلان” عن معارض عانى بدوره من الاعتقال، فيتولى ابنه سرد حكايته إذ مذ تفتحت عيناه على الدنيا وهو يشاهد والده جالساً ببيجامته في الشرفة لا يبارحها حتّى موعد النوم: “بدا لي جلياً وأنا أنتقل إلى المدرسة الابتدائية، أن آخر فعل قام به أبي هو زواجه من أمي وإنجابي، وبعدئذٍ قرر اعتزال الحياة كلّياً، وملازمة الشرفة والتفرغ كلّياً للشرود. ففي حسبة بسيطة فإنه كان يمضي ثلاثة أرباع يومه جالساً على كرسي فيها، يمارس شروده، رفقة القهوة وسجائر “كنت” الطويلة ناصعة البياض، بوصفهما أداتين مكملتين ومتناغمتين مع الشرود.” وفي ضوء هذه الملاحظة وبمنطق الطفل يسمّي الطفل أمّه “سوبر وومن” ووالده “سنفور كسلان” ويسمّي نفسه “سنفور غضبان” لكنّ أمّه ستخبره بأنه أخطأ في حقّ والده فهو رجل محترم ومهم، ولم يفهم الطفل ذلك إلى أن جاء يوم اعتقلوه فيه مجدداً وغاب لمدة سبع سنوات لزمت الأمّ خلالها الشرفة منتظرة عودته: ” أمضى أبي سبع سنوات في شرب فنجان القهوة، وكان قد أمضى قبل أن يحب ويتزوج ويرزق بي، عشر سنوات في احتساء فنجان قهوة آخر دعي إليه في السابق.
نعم لقد أمضى أبي سبع سنوات جديدة في المعتقل، أمضت أمي نصفها آخذة على عاتقها تولي كل ما تركه خلفه من مهام، حتّمت عليها ملازمة الشرفة والتفرغ للشرود والتدخين، وتجرع كؤوس العرق الممتزجة بدموعها وحيدة في المطبخ، والتنقل بين محطات الراديو من دون أن تستقر على إذاعة، ولا أن تنام مع “الشعر والليل موعدنا” ولا غيره من برامج وأغاني، لأنها لم تكن تسمعها جميعاً بل تكتفي بصخب ذبذبات الراديو، مواظبة على الخروج في الثالثة فجراً إلى الشرفة، لتدخن سيجارة تلو الأخرى، وهي لم تنم بعد، إلى أن عدتُ يوماً من المدرسة فرأيتها على كرسي أبي في الشرفة وبين أصابعها سيجارة حرّقت أصابعها، وقد نامت نَوْمةً لم تستيقظ منها أبداً.”
المفارقات السرديّة الحزينة
تذكّرنا قصص “سورية يا حبيبتي” بما اصطلحوا عليه سابقاً “الواقعية النقدية” كمقصد أساسي تتأسس عليه اللغة الساخرة المستمدة من مفارقات الواقع السريالية التي باتت أشبه بالمسلّمات يلتمسها القارئ بدءاً من عنوان المجموعة اللافت كعتبة أولى تنهض على إسقاط لابدّ منه، حتّى بالنسبة للقارئ العادي، فأنشودة “سورية يا حبيبتي” هي أغنية وطنية شاعت سابقاً، أزدهى فيها السوريون بأمجادهم وكفاحهم وكرامتهم، مما يدفع للمقارنة بين خطاب الأمس واليوم والسلوك العام الذي انعطفت به الحرب جذرياً، فيستعرض القاص عدداً من النماذج الإضافية لشخصيات ملتمسة في الواقع منها الأمني ومنها الإرهابي إذ سادت الوحشية سلوكات الشباب الذي وجد نفسه أمام خيارات أحلاها مرّ، فجنح بعضهم إلى خطف البشر كرهائن لابتزاز أهاليهم أو نحو الإرهاب معتقداً أن خلاصه في حمل السلاح والقتل كما في قصّة “ضوء” ليكشف لقارئه مقدار الوهم الدونكيشوتي الذي يعيشه الكائن المنضوي في الجماعات الإرهابية على النحو التالي: ” أنا في حفرة بطولي تماماً، أرصد أي تقدم أو حركة أو نأمة يأتي بها العدو، أنصت طالما أن ستاراً من العتمة منسدل بيني وبينه.. اللهم ثبّت أقدامي وانصرني على القوم الظالمين.” والمفارق في عتمته هذه أنه كلّما لمح ضوءاً يخاله ملاكاً جاء ليبشره بالنصر إلى أن يسقط بأيدي أعدائه.
ومثل هذه المفارقات ملتمسة في سائر القصص اعتماداً على اللغة والموقف من الحدث كما في قصّة “القائدان” وهي تتناول ما سمّى التدريب العسكري لطلاب الجامعة في معسكرات إلزامية في العطل الصيفية والغرض معروف هو عسكرة هذه الفئة من الشباب وإخضاعهم لنظام الطاعة العام، والمفارقة أن النتيجة المتوخّاة من ذلك عبثية ولا معنى لها، إذ يستعرض القاص حالة الملل العام: (إنه معسكر التدريب الجامعي الصيفي، فأهلاً ومرحباً بكم.
اجتمعنا فيه نحن الثلاثة آلاف طالب وهتفنا للقائد الخالد:
“بالروح بالدم نفديك..”
وصفق لنا عضو القيادة القطرية والرفاق والضباط المصاحبين له، وقال لنا الأول:
“إن القائد الخالد يسأل حتى عن الملعقة التي تأكلون بها..”
فجددنا هتافنا، ووصل عنان السماء وزلزل كل ما حولنا من جبال وأشجار وقرى، وعدنا إلى خيامنا، وأمضينا كامل الوقت في تزجية الوقت، في استكمال للخطة المحكمة بالتعامل مع جرعات مفرطة من الملل.) والمفارقة الساخرة جليّة في هذا المجتزأ ما بين الحماسة الشعارية وحياة الملل، ومن جانب آخر يدرك الضباط والطلاب مدى عبثية هذا القرار واللاجدوى منه: “ووفقاً لما تقدّم، فإن معشر هؤلاء الضباط وصف الضباط أيضاً توصلوا إلى إيمان مشترك عميق، بأن ما يعطونا إياه هراء بهراء، ولا معنى له طالما أننا أرباع جنود، مكتفين بالقدر الذي يتيح للطالب أن يصبح كائناً هرائياً، يتلقى معلومات هرائية بشرود تام، والشيء الوحيد المهم هو النجاح بمادة التربية العسكرية المقررة.” وإذا كان هذا الملل و”الهراء” ناجم عن قناعة المتدرّب وقائد المعسكر، إلاّ أن ثمة قائد آخر سيعمل على تدريبهم بقسوة شديدة بغية تحويلهم إلى وحوش كاسرة وهلم جرّا.
وفي ختام هذه الدراسة لابدّ من الوقوف عند قصّته الموسومة بـ “فيلم ملحمي” ذات البنية الرمزية التي تختصر مقاصد المجموعة كافة في الإشارة إلى الأساس الذي انطلق منه كلّ هذا العنف غير المبرر لشعب واحد كان منذ حين يتغنّى بالحاضنة الأم سورية العزّة والكرامة.
فثمة سارد للقصّة وثمة مخرج أشبه بكاليغولا صارم ومشهور، وثمة جموع كبيرة من الكومبارس يؤدون دوراً هامشياً محدداً يتلخص في رمي أنفسهم من أعلى الجبل إلى البحر والمفارقة المحزنة قد يلخّصها الحوار الختامي ما بين السارد والمخرج: سألت المخرج وأنا أشيع بناظري معشر الهاربين السابحين:
“هل سيغرقون؟”
أجابني وابتسامة ظفر عظيم على وجهه:
“لا يهم! المهم أنها نهاية.. نهاية عظيمة بلا ريب”.
الخلاصة
إبداع زياد عبد الله ناجم عن نظام تفكير متقدم وحساسية بصرية ولغوية خاصة به، ولا سيما في أسلبة السرد باتجاه المفارقات الدرامية الساخرة، كما في روايتيه “بر دبي” و ” كلاب المناطق المحررة” الرواية التي تستحقّ الإعجاب والإشادة لما اجترحه من فنون السرد المعبّر عن ذات إبداعية تنثر عبقها في النفوس والأمكنة. يتجلّى واضحاً في التوسع في الخيال والتخييل واستعادة زمان الروّاد الكبار في تناول الجوانب السوسيوثقافية ومختلف ما يتفرّع عنها من أطر ترتبط بتقنيات السرد العفوي البسيط في شكله والعميق في دلالاته بما اجترحه من تناص ومتفاعلات نصّية ترتبط بالمقاصد وتعزز وجهته الكتابية كتجريب عالي المستوى مرتبط بواقع غرائبي سريالي قد لا يحدث إلاّ في بلدان بعينها!