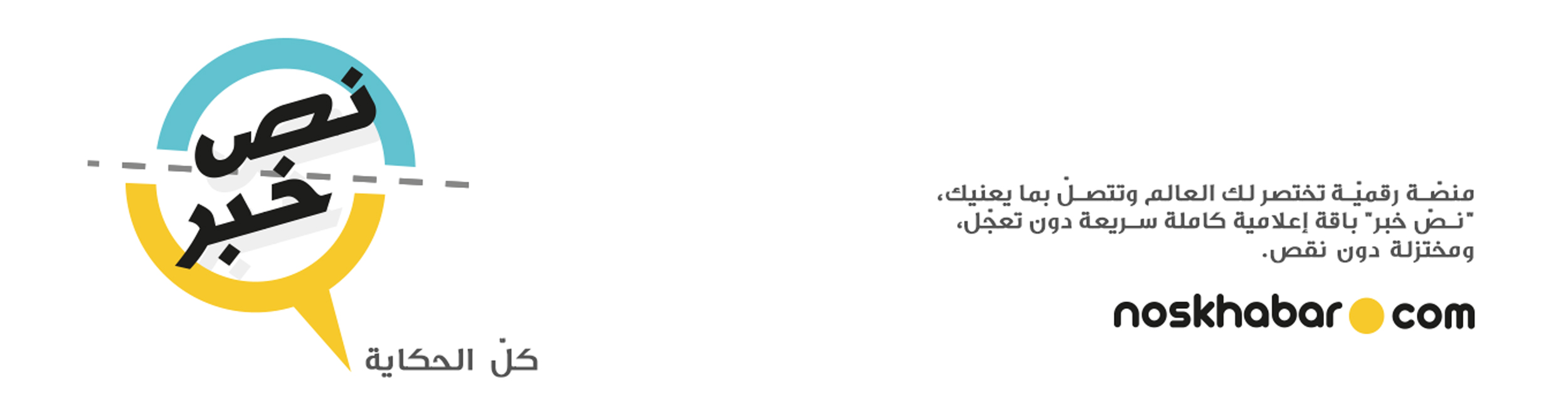24 فبراير 2024
نص خبر – متابعة
يعدّ الرّمز من أبرز الظّواهر الفنّية في النصوص الأدبي عامة، وفي الشعر المعاصر على سبيل الخصوص؛ وهذا ما أكّده عز الدّين إسماعيل في قوله: “من أبرز القضايا الفنّية الّتي لفتت الانتباه في تجربة الشّعر الجديد ظاهرة الاستخدام المكثّف للرّمز كأداة تعبيرية استعملها الشّاعر لإيصال فكرته إلى القارئ” (19)، فالرّمز يقوم على إخراج اللّغة من وظيفتها الأولى وهي التّواصل وإدخالها في الوظيفة الإيحائية “لأنّ النّفس إذا وقفت على تمام المقصود لم يبق بها شوق إليه أصلًا أمّا إذا أجهد المبدع نفسه في التّخيّر شدّ انتباه المتلقي وجعله متعطشًا لمتابعته”.
وقد تعدّدت مفاهيم الرّمز فنجد غنيمي هلال يعرفه قائلا: “الرّمز هو الإيحاء، أي التعبير غير المباشر عن النّواحي النّفسية المستمرّة الّتي لا تقوم على أدائها اللّغة في دلالاتها، فالرّمز هو الصلة بين الذّات والأشياء بحيث تتولّد المشاعر عن طريق الإثارة النّفسية لا عن طريق التّسمية والتصريح”.
ويرى صلاح عبد الصبور أن الحاجة إلى استعمال الأساطير قد نبعت بتأثير النزعة الجديدة إلى تجلية علوم الإنسان كعلوم الانتروبولوجيا والاثنولوجيا و النفس، فقد كان العلم يرى في هذه الاهتمامات حتى عهد قريب مجموعة من المواد المبعثرة لا تستطيع أن ترقى إلى مستوى العلم. وحين اتجه الإنسان إلى هذه الرموز والأساطير رأى في هذه المواد المبعثرة كنوزًا من التجربة والمعرفة، فحاول أن ينسقها في علوم استدلالية، محاولًا أن يعرف الإنسان عن طريقها، بعد أن فشل في معرفته عن طريق العلوم التجريبية الحديثة.
وقد لجأ العديد من الشعراء المعاصرين إلى التاريخ، واستمدوا منه كثيراً من الشخصيات والأحداث التي وظفوها في أشعارهم للتعبير عن مواقفهم بشكل غير صريح أو لتعويض نقائص عصورهم، حيث “اتخذ الشاعر من هذه الشخصيات أقنعة معينة، ليعبر عن موقف يريده، أو ليحاكي نقائص العصر الحديث من خلالها”.
أما نازك الملائكة فقد واصلت دراسة اللغتين اللاتينية والفرنسية وظلت تحفظ قوائم تصريف الأفعال وتغيرات نهايات الأسماء اللاتينية وفي الوقت نفسه بدأت بكتابة ملحمة أدخلت فيها أساطير عربية وإغريقية وبابلية ووجدت أنها بدأت مرحلة جديدة في تطور شاعريتها.

فيما يُعد توظيف الرمز في القصيدة الحديثة سمة مشتركة بين غالبية الشعراء على مستويات متفاوتة من حيث الرمز البسيط إلى الرمز العميق إلى الرمز الأعمق؛ ومع أنَّ الرمز أو الترميز في الأدب عامة سمة أسلوبية، وأحد العناصر المهمة والجوهرية في النصوص الأدبية منذ القدم إلَّا أنَّنا نراه قد تنوع وتعمق وسيطر على لغة القصيدة الحديثة وتراكيبها وصورها وبنياتها المختلفة، والرمز بشتى صوره المجازية والبلاغية والإيحائية هو تعميق للمعنى الشعري، ومصدر للإدهاش والتأثير وتجسيد لجماليات التشكيل الشعري، وإذا وظف الرمز بشكل جمالي منسجم، وباتساق فكري دقيق مقنع، فأنَّه يسهم في الارتقاء بشعرية القصيدة وعمق دلالاتها وشدة تأثيرها في المتلقي.
واستلهم شعراؤنا من معين رموز الأساطير، والتاريخي والثقافي والديني صورًا فنية دالة أغنت نصوصهم الشعرية وعمقتها فكريًّا وجماليًّا، كما تميزت أشعار محمود درويش على سبيل المثال في دواوينه الأخيرة بتوظيف الرموز المختلفة بشكل مكثف عميق موح، حيث ارتقت القصيدة العربية الحديثة إلى مستويات إبداعية مبتكرة متطورة تتوازى مع أعظم الأشعار العالمية في القرن العشرين.
وفي هذا الإطار يحتفي ملوك في أغلب قصائده بعدة رموز أسطورية، وتاريخية ودينية يوظفها لتعبر عن مكنون أفكاره واتجاهاته في الإعلان عن ملكته الإبداعية حتى أضحت تلك الرموز من السمات الأساسية التي تميز إسهاماته الشعرية مذ بضع سنين، وكانت قصيدة “من فم الراوي” أحد أهم هذه القصائد التي وظَّف فيها ملوك عدة رموز متنوعة ومختلفة ما بين الرموز الأسطورية لحضارة ما بين النهرين وكذا الرموز التاريخية والدينية بحسب تسلسلها الزمنى حتى يعبر من خلالها عن الإطار العام الذي يحكم تجربته الإبداعية وأسلوبه في عرض ما يجيش في خلجاته بشكل مجازي عصي يحتاج قسط عظيم من الإدراك، والثقافة، والتدبر، لمحاولة تأويله واستبيان نفائسه للوقوف على بيت القصيد والتيمة العامة التي أرد ملوك بثها من خلال قصيدته، وقد عمد الشاعر إلى التكثيف في استخدام الرمز في نهاية القصيدة فيقول:
****
لا كالذي يطلبُ الدنيا
فإن رضِيَت
فدُونَها يملأُ الدنيا عراقيلا
ولا الذي زُيِّنَ الماضي لِيَدخُلَهُ
وليسَ إلا بما يخشاهُ مأهولا
رأى “المسيحَ” من “الأقصى” على جبلٍ
فظنَّ “آدمَ” لم يُقنِع “عزازيلَ”
ومثلما وثنيٌّ ضلَّ وِجهتَهُ
لولا تَميمتُهُ لارتدَّ مقتولا
أفضَى- وطوفانُ “نوحٍ” من حكايتِهِ
يُكَسِّرُ الموجَ بِرميلًا فبرميلا-:
لو أن “إنليلَ” لم يَهمِس لصاحِبِهِ
ما كانَ مِن جبلٍ
لو أن “إنليلَ”…
وفي الحياةِ مواعيدٌ مؤجَلةٌ
أجلُّها دائمًا يزدادُ تأجيلا
****
يعبر بنا ملوك من حضارة ما بين النهرين إلى الأساطير والرواة الأولى ثم الرموز في الكتب المقدسة والعهد القديم إلى الأماكن وبيت إيل إلى رموز الأنبياء وما ورد في الكتب المقدسة من رموز سطَّرها الشاعر لحضارة عريقة أسقطها الشاعر على واقعنا المستهان الذي بات فيه الدولار بطلًا والبترول مقايضًا لتلك الحضارة التي صنعت تاريخ الأمم بل أصبح البترول عند البعض أغلى من شموخ حضارتهم ولم يبق أمام الشاعر سوى الدعاء إلى المولى عز وجل، رموز عظيمة وأمثلة عديدة بث ملوك من خلالها الحكمة والموعظة الحسنة فهو ليس كطالب الدنيا الذي يملأ الحياة بالمتاعب والصعوبات إن لم ترضَخ لطلبه، ولا يزين الماضي ليدخله مؤهل بالخوف، إلى حيث رؤية المسيح عليه السلام وهو رمز المحبة والسلام ” رأى “المسيحَ” من “الأقصى” على جبلٍ” فأين الأقصى من هذا السلام، وهل يظن “آدمَ” لم يُقنِع “عزازيلَ”.
إنَّ “عزازيل” هو أحد أسماء الشيطان في الميثولوجيات الدينية، حيث يجسد نزعة الإنسان إلى “الشر” بالمفهوم الديني، في إيماءة فطنه من الشاعر إلى أن الأنبياء لم يستطيعوا إخماد نوازع الشر في بني الإنسان، ولكننا نود هنا الإشارة إلى تعبير “شيطان الشعر” في صياغة ملوك للرموز بهذا التوظيف الموفق، حيث نشير إلى العلاقة ما بين الشيطان والإبداع، في إشارة إلى أنه يجسد النزعة إلى التفكير الحر والتمادي في الخيال والربط بين الرموز والواقع بما يعج من أحداث مؤلمة ومواقف فاجعة وظروف قاحلة.
ومن الرموز الدينية ما بين أدم وعيسى عليها السلام إلى عُباد الأوثان والضلال والتعلق بالتمائم إلى نوح والطوفان العظيم الذي انتهى -حسبما يرى ملوك- بتكسير الموج المصنوع من الأوعية الخشبية والمعدنية المُستديرة من خشَب فلا يوجد بعد هذا المشهد التراثي الحضاري من شيء لحفظ السَّوائل والغازات فقد بيعت ببخس لأعداء الأمة ثم الفلاش باك مرة أخرى على رمز من رموز حضارة ما بين النهرين والاتكاء على ما يُعرف بالإله “إنليل” كرمز من رموز السلطة ذوي المناصب العليا في البلاد، ويعود نسبه إلى أصل الكلمة السومرية للكون وهي آن-كي، التي تشير إلى الإله آن والالهة كي، وابنهما كان إنليل، إله الهواء، وكانوا يعتقدون أنَّ الإله إنليل كان الأله الأقوى، كان الإله الرئيسي لمجموعة الآلهة أو البانثيون، مثلما كان للإغريق زيوس وكان للرومان جوبيتر.
وقد سمح (مجمع الألهه)، لإنليل بالمطالبة بمنصب الإله الأقوى، وظل إنليل كبير الالهة ولفترة طويل من الزمن حيث حكم باسمه الملوك وبناءً على رعايته وطَّدت سلطة الحكام وشرعت القوانين فتم ذكره في مقدمة قانون أورنمو ومسلة حمورابي.
وقد وصف إنليل بأنه “ملك الأراضي الخارجية”، وأحيانًا بـ “العاصفة الثائرة” كما أطلق عليه “الجبل الأعظم” وهو ما أشار إليه الشاعر محمد ملوك في المقطع السابق في سياق إبحاره في عالم الأساطير والرموز ما بين الحضارة والأسفار حتى يصل بنا إلى فصل الخطاب وحكمة الحياة في بيته الخالد حيث يقول: “وفي الحياةِ مواعيدٌ مؤجَلةٌ *** أجلُّها دائمًا يزدادُ تأجيلًا” نعم ما أكثر المواعيد المؤجلة التي أعظمها وأهمها دومًا يمعن في التأخير ولعلَّ من أجلِّ هذه المواعيد المؤجلة في الحياة الدنيا هو يوم الوعد والوعيد واليوم الموعود “يوم القيامة”، وبشكل عام كلما أجلت المواعيد عظم شأنها، فنرى أنَّه كلما أجَّل اللقاء والمواقيت بين الأحبة ازداد الحبُّ توهجهًا وعظم أمره، أمَّا عند اتمام اللقاء فيكون الأمر أقل حدَّة وأقل جللا، وهكذا دائمًا المواعيد المؤجلة جليلة عظيمة ننتظرها بشغف، إنَّها حكمة بالغة بثها ملوك ليأكد على حقيقة مهمة أنَّه كلما ازدادت شفافية الشاعر جرت الحكمة على لسانه فنتلمسها فيما يكتب حتى وإن ظلت بعض الرموز في معانيها المرادة مبهمة وعصية التأويل، ربما يحتفظ ملوك بمفاتيحها حتى يظل القارئ في صراع مع النص حتى النهاية، وهو أمر مقصود ومتعمد من الشاعر حين يحلق في مرايا التاريخ فتتأرجح ذاته بين ما كان وما هو كائن وما ينبغي أن يكون.
بعيدا عن محاولتنا ولوج عالم ملوك الشعري من خلال الأساطير ورموزها يجدر بنا الإحاطة بمجمل الدوافع التي دعت ملوك إلى اللجوء إلى ذلك التراث الإنساني الموغل في القدم ليستلهم منه تلك الأجواء الروحية العميقة وملامح البطولة الإنسانية المتفردة التي تجسدت بأفعال الشخصيات الأسطورية وتطلعاتها ومواقفها إزاء الحياة الإنسانية وما يحيط بها من غموض وتعقيد.
وإذا كانت الأساطير في مضمونها العام حكايات أو قصص غارقة في الخيال والتصورات الخرافية بوصفها مجافية للمنطق الحضاري الحديث فكيف يمكن أن يكون اللقاء بين ملوك كشاعر معاصر وبين صانع الأسطورة؟ إن نظرة فاحصة متعمقة في صميم العمل الشعري والبناء الأسطوري تظهر لنا بجلاء مدى الصلات الحميمة التي تربط بين هاتين الظاهرتين، ولعل أبرز تلك الصلاة هي البناء اللغوي وأسلوب الأداء التعبيري اللذان يتجاوزان حالة التشابه إلى حالة مهمة من التطابق الذي يثير في أذهاننا الاعتقاد بأنَّنا في روض إنسان بتلك الثقافة الأسطورية وكيف أمكنه صياغتها لغويًّا حتى يعبر بها عن تصوره وإدراكه للواقع وإنَّنا برغم ما نملك من نظرة موضوعية ما زلنا نحتفظ بتلك اللغة المفعمة بالحياة والرموز ولعل الصفة الأسطورية للتراكيب اللغوية والمفردات اللفظية من المسلمات التي يقوم عليها العلم الحديث في أصل اللغة؛ فضلًا عن ذلك كله إنَّ البناء الأسطوري في شعر ملوك لا يتضمن عنصرًا نظريًّا أو فكريًّا فحسب بل إنَّه يحمل عنصرًا فنيًّا ذا طابع إبداعي على نحو أنَّ الشاعر وصانع الأساطير يعيشان في عالم واحد فلم تعد الأسطورة مرتبطة بمرحلة تاريخية بدائية لأنَّ الفن لا ينقد إطلاقًا الخيال الغرائبي الذي تصوره الأساطير بل يتجدد مع كل فنان عظيم، وشاعر ملهم في كل العصور وتصوره للكون من حوله.
أنَّنا نؤمن أنَّ عودة الشاعر العربي المعاصر إلى التراث لا بدَّ أن تكون عودة فنية لا تقوم على أساس المتابعة والتقليد فقط، كما أنَّها لا تدعو إلى المقاطعة والإهمال وإنّما هي عودة يستثمر فيها التراث في إسهاماته الأدبية والتي يجب أن تجمع بين الأصالة والمعاصرة/ كما أنَّ الشاعر إذا لجأ إلى استخدام الشخصيات التراثية كمعادل موضوعي لتجربته الذاتية فإنَّه يتخذها قناعًا يبث من خلاله خواطر وأفكاره، وآراءه، ومعتقداته.
كما أنّ التراث خُلق للحياة والخلود ليحتضن التجربة ويقدم الرؤية بأسلوب قوامه التلميح والترميز، واللغة أساسها التفعيل والتكثيف لتشع إيحاء، وبموجب هذا التوظيف تحول النّص الشعري المعاصر إلى متن مفتوح على مختلف القراءات في ارتباطه بمختلف الأزمنة والأمكنة، لذا كان التراث جذور الشاعر الممتدة في عمق التاريخ والذي يعبر عن ثقافة الشاعر، فالتراث عند الشاعر هو سمو للروح ونبع للإلهام؛ ومن هنا ذهب الأدباء المعاصرين وخاصة الشعراء إلى مثاقفة التراث وتفعيله بوصفه مُعطى حضاريًّا وشكلًا فنيًّا في بناء العملية الإبداعية للتعبير من خلاله عن الرؤى والأفكار.
وحسبما نرى إن النص الشعري لن يحقق الدلالات الجمالية والأبعاد الإيحائية التي تمنحها الأسطورة، إلا إذا تعامل معها الشاعر من منطلق متبصر وواع يقتضي الدقة الكاملة في توظيف إمكانات الأسطورة، والتمكن منها كمادة مرنة قابلة للتكيف والانصهار في بوتقة القصيدة، لهذا ينبغي أن يكون التعامل مع الأسطورة نابعًا من اقتناع ذاتي، ليس بوصفها تراثًا جامدًا، أو حكايات تاريخية تأسرها ثنائية الزمان والمكان، بل باعتبارها شعلة إنسانية متجددة لا ينطفئ لهيبها، ونتيجة لذلك ينبغي توظيف الأسطورة توظيفا مغايرًا لظرفها السوسيوتاريخي، وعلاقتها بالتركيبة الذهنية التي أفرزتها.
إن أهم قضية يجب مراعاتها حينما يتعامل الشاعر مع الفكر الأسطوري، هي قضية الرؤية والموقف بالنسبة للزمان والمكان، ذلك أن خلود الأساطير وقدرتها على أن تشكل موقفًا فكريًّا وجماليًّا، هي قدرتها على تغييب الزمان والمكان وإلغائهما بحيث يبدو زمان الأسطورة هو كل الأزمنة، فالأيام دول والمواقف تتكرر، وكذا ينبغي أن يكون مكان الأسطورة هو كل الأماكن، إنَّه زمان عصي على التحديد؛ أي أن الزمان الأسطوري هو زمان كلي وشمولي، والمكان الأسطوري من أهم سماته أنَّه لا يتحدد بخصائصه الجغرافية، إنَّه مكان متخيل ينفتح على كل الأماكن ليشمل أزمنة لا محدودة من الماضي والحاضر والمستقبل.