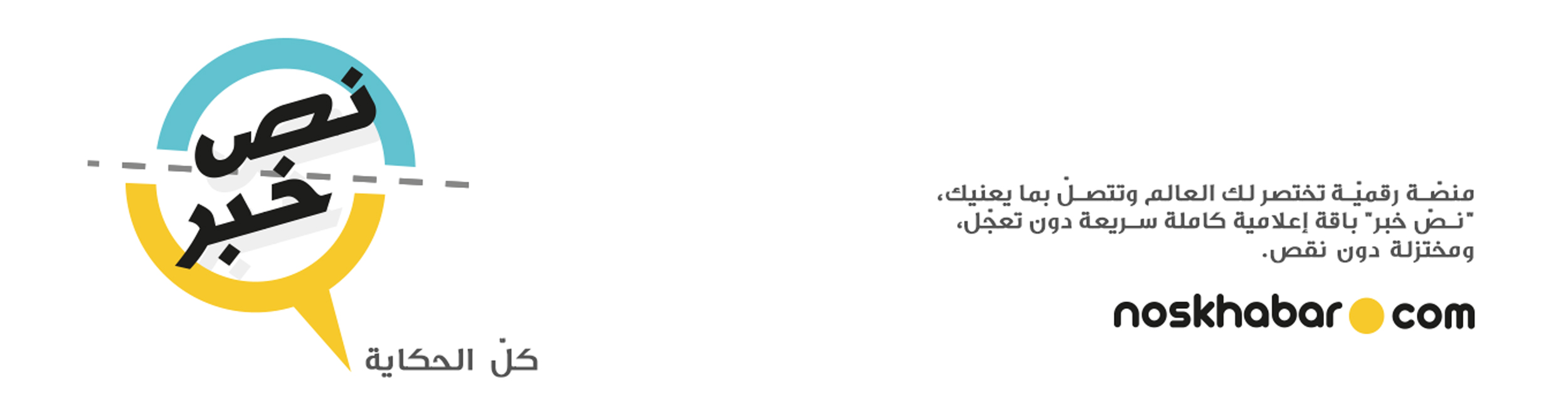جهينة العوام – كاتبة وصحافية سورية
قالت لي.: فيما مضى كانت الألوان والألعاب تندلع في المكان كلما التقينا، نركض على الدرج وتتقافز الضحكات بيننا، كنت أحزر مفاتيح ضحكاتهم وشيفرة مزاجهم، لم يكن في معجمهم اللغوي إلا ثلاث كلمات ومع ذلك تكدست حكاياهم في كل زوايا البيت، وعلقت رائحتهم على سرير القلب.
كنت أغني لهم وأحكي تلك الأحاديث العصية على الأبجدية والمرفقة بإشارات مرتجلة ، لكنها كانت كافية ومثالية لنهاية يوم غني . أما اليوم فتتطاير الأحاديث مرتدية صورة أمكنتها، بينما الكلمات تبدل جلدها تجر خلفها أرواحا مكسوة بالملح والريبة، وأنا حالي كحال آلاف الآباء و الأجداد الذين عاصروا التغريبة السورية وشربوا كأس المرار طائعين قبل أن يمر القطار على ما تبقى من ضحكاتهم، فرًت غزلاننا من خاصرة الروح وتركت تلك الفجوة مفتوحة تنز حنيناً وقهراً.
وها نحن مصلوبون أمام الشاشة، محشورون بذات الفجوة الهشة و الرطبة كالطحالب، نكوي تجاعيد الوقت بضحكاتهم، وبالزيت الراشح من ذكرياتهم ندهن فقرات عمودنا الفقري، نمسد الشوق غصة غصة ونحن نتوسد أَسرَتهم، وننشر ثيابهم على الحبال ونجلس قبالتهم حتى تتعب من التأرجح ونتعب من الانتظار ، نعادل ضغطنا بألبوم صور بهتز كعصفور بين راحتينا بينما تحوم كلماتهم حولنا مخافة أن يلتهمنا اليأس.
وتجنبا للاعتراف بالرعب الذي يخيم على وحدتنا، ننشئ مجموعة على تطبيق ما ونسميه (جروب العيلة) لتنظيم لقاءات دورية، بعد إجراء عدة محاورات عاطفية لإقناع الصغار، بضرورة تبادل الحديث مع كائنات منفية في جهة أخرى من العالم، كانت فيما مضى تربطهم بها صلة رحم من الدرجة الرفيعة. كغيري من الجدات أعرف أن هذا ما يجري قبل الزيارة الافتراضية وأن أسلوب التربية الحديثة يقتضي حوارات طويلة ونقاشات على أعلى المستويات التي تستنزف كل الطاقات بما فيها الاحتياطية، ثم تفتح ستارة المسرحية الدرامية.
ويتم الاتصال بنجاح الأبناء والأحفاد من جهة وأنا على المقلب الآخر، يتكلم الجميع عبر الشاشة، تختلط الأصوات والدموع والأشواق والحنين والتململ والضحكات. يتصنع الطرفان الرضا والقبول للطريقة المعتمدة في هكذا زيارات باتت شائعة، وعلى حد قول الكثيرين إنها تفي بالغرض وتطفئ الشوق.
لقد روضتني الأيام والتكنولوجيا وبات الأمر يصبح أقل ارباكاً، بالنسبة لي القصة بأكملها لن تكون مرضية ولا مقبولة،هذه الشاشة تقوم مقام جدار الفصل الروحي، وما زاد الأمر سوءاً خاصية اللمس، التي تمنعني أن ألمس الشاشة عندما يقترب حفيدي ليقول هاي (أو ربما كلمة أخرى لا أفهم ما تعني، فقد اعتدت أن لا أهتم بما يقول، اكتفي فقط بتأمل حركة السنين بيننا) أو تهمس ابنتي (ست الحبايب، الله لا يغلبك)!
غلبتني السنين يا أولادي وخانتني تلك الأحلام التي كنت أدخرها لشيبتي. تقطع ضحكتها “التي حاولت مرات عديدة ان التقطها واعلقها في دبوس بشعري كي تظل قريبة من سمعي”.. ما يدور في داخلي وتعطيني فرصة أن أمسح العرق بمنديل، وأقفل مجرى الدمع بإحكام.
مع السنوات بات الأمر يزداد صعوبة وحرقة، الحبل السري الذي كان يوصل الطعام بأمانة، لأولادنا في الرحم و يتقن لغة الروح ، قطعته التعرفة الجمركية للأمكنة الجديدة وتكفلت السنين باطعام ما تبقى منه لعقارب الساعات. كيف يمكن برمجة اجتماع عائلي وتحويله الى خوارزميات كي ينال تقييماً ناجحاً ويفي بالغرض؟
يزداد الأمر تعقيداً كل لحظة، فاليوم باتت الدعوة للم شمل العائلة ولو مجازياً، كدعوتك لاجتماع دولي. حضرت نفسي جيداً كي يكون لقائي بهم مميزاً وممتعا علني أكسر الجليد المتراكم بيننا، حذفت الكثير من كلماتي التي تتطاير دون رقيب حالما ألمحهم، (يؤبرني وجهك ، تكفني ضحكتك ) والتي ستبدو غريبة وربما تصيب أحفادي بصدمة نفسية اذا تمت ترجمتها للغة أخرى.معهم حق! ألا تتسع الدنيا لنا جميعا؟! لا أعرف من أدخل هذه الجمل، وحشرها تحت اسم الحب والعاطفة والحنان الزائد، سأستبدلها ب(يخليلي ضحكتك وقلبك).
انضم ابني المقيم في هولندا وأخته التي تسكن كندا، وصغير أبنائي الذي سبقهم إلى دبي والكبير المستقر منذ زمن ليس ببعيد في النمسا، كانت لدي رغبة كبيرة أن أجمع أحفادي وأحكي لهم حكاية تحمس أبنائي للفكرة، أو هكذا افترضت! فربما قرروا أن يجبروا بخاطري، أنا التي رفضت السفر وترك بيتي القديم في الجبل .بالفعل جلست قبالة الشاشة وبدأت الحكاية وأنا أنتظر على أحر من الجمر كي أجذب انتباه الأطفال (كي نؤسس معاً لجروب التيتة والاحفاد والذي سأخصصه للحكاية) الذين كانوا في غربة عن كل ما يحدث، الأمر برمته بالنسبة اليهم كان عبثيا ومشوشاً ،أما أنا فقد كنت فخورة بنوعية الحكايات التي أكتبها وأحفظها، وأسابق لهفتي للفوز باهتمامهم ولو بكلمة أو قبلة أو عناق افتراضي، أدسه تحت مخدتي أو ربما أعلقه كي يتدلى ويتراقص قبالتي، أو حديثاً صباحياً أتباهى به أمام جاراتي، أو مكالمة طويلة أنقل فيها تجربتي الى صديقتي وفاء.
بكامل فرحي جلست وأنا استعمل جسدي كله للتعبير و تخرج الحكاية جملة جملة، يقابلني وجوم من الشاشة ،وقبل أن أصاب بالإحباط،سارع أولادي لترجمة الحكاية، كل واحد بلغة البلد الذي يعيش فيه كنت أنصت وانا اسمع حكايتي تترجم الى أربع لغات ،كلماتي تتفلتر وتتشذب روحي بما يتوافق والثقافات الأخرى ، ثم يصمت ابنائي ويبتسم الصغار ،أكمل قراءة مقطع جديد ويتولى من جديد أولادي الترجمة ، بينما أتولى ترجمة خيبتي الى وجع لن يعرفه سواي. هذا الزمن الذي يعترض كلمات الروح كحاجز تفتيش يفرغ جيوبها من اللهفة بحجة الترجمة مؤلم حقاً لحظات الانتظار لا تحترم شغف اللهفة وتدفق العاطفة ، عجوز في عمري يهدر الحب والشوق واللهفة داخلها لن تحتمل أن تبني اللغة سداً وتحجز كلماتي خلفها.
عندما كانوا صغارا ابتكرنا معا إشاراتنا ورقصاتنا وكان لأسرارهم غمزة أو حاجب مرفوع، وكنت الفيتو الذي يرفعونه بثقة، وكنت ملجأهم الحنون. في منتصف الحكاية جدلت الغصة حبال الصوت على شكل مشنقة ، غادرت بحجة انقطاع النت جلست على كرسي الهزاز قبالة النافذة انظر الى الجبل المختبئ تحت الثلج كانت الغرفة حارة أكثر مما ينبغي ففتحت النافذة ودخلت نسمة باردة ، كان بكاءً عميقاً أحسست به يأخذ دربا مرتجلا كي يصب في القلب مباشرة .