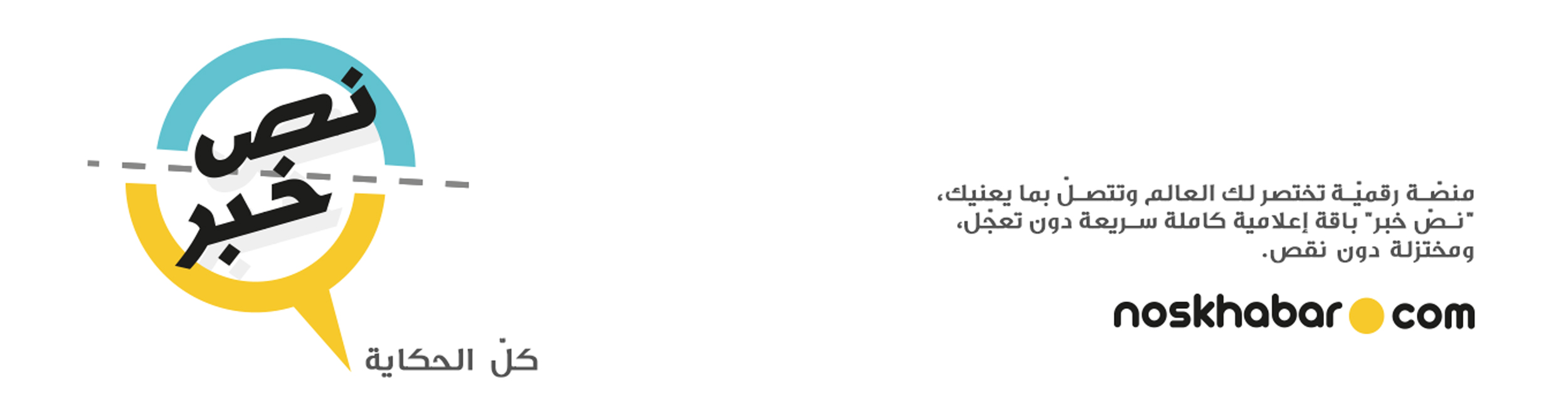ريم يونس – كاتبة سورية
كان هذا السؤال الذي سمعتهُ صباحاً في برنامج إذاعي باللغة الهولندية قبل ذهابي للعمل، وفي الطريق حاولتُ البحث في الموبايل عن اسم المحطة الإذاعية التي طرحت السؤال لكنني لم أجدها. وبقي السؤال يتردد في ذهني.
كانت هذه الفكرة أثقل من أن أقدر على حملها في رأسي لوحدي وعلى الرغم من رغبتي الشديدة بالحديث عن ذلك وحاجتي لمن يشاركني الإجابة عليه، إلّا أنني لم أتحدث مع أحد من زملائي في العمل في ذلك اليوم!
لا أدري لماذا اقترنت في ذهني فكرة الحديث عن ثيمة البيت بأن تكون حصراً بلغني الأم “العربية” وألا تكون بلغة أخرى أتحدث بها.
وهكذا خلال بقية اليوم بدأتُ أعيد تعريفات البيوت التي سكنتها على مدار العشر سنوات الماضية، كيف أننا في كل مرة كنا فيها ننتقل إلى بيت آخر وفي مكان مختلف، ألقي نظرة أخيرة على تفاصيل البيت وأضيف المشهد إلى مسرح البيوت في رأسي.
لم يكن أيٌّ من المشاهد مكتملاً، بل كان كل بيت أسكنه يحاول أن يلعب دور البطولة، لكنه كان يفشل أمام موجة حنين صغيرة للنوم عصراً تحت الشباك الغربي في بيت أهلي.
هذا عن البيت، ماذا عن المكان؟
هل استطعتُ أن أنتمي لكل هذه الأماكن التي أقمت فيها؟ هل استطعت أن أكون بكامل العري الروحي وبدون أن أخفي قطعاً من بازل شخصيتي؟ هل وثقتُ بالأمكنة وبجدرانها إلى الحد الذي علّقت عليها ذاكرتي كصور؟
الكثير يؤمنون أن البيت هو حالة عاطفية، أي أنه حالة ذهنية أكثر من كونه مكاناً مادياً نعيش فيه.
ضحكت صديقتي التي تعيش في سوريا من سؤالي، شتمت الحياة والأوطان ثم قالت: “البيت هو أن تستدين أضعاف مرتبك حتى تدفع إيجار سقف أبله لمدة شهر فقط، غير ذلك التعريف هو رومانسيات من عالم موازي! الحنين للبيوت الذي تتحدثين عنه سحب كل ما تبقى من إنسانيتنا وهرب.”
أعتقد أننا نعجز بعيداً عن بيوتنا التي تركناها في أوطاننا عن إعادة ترتيب المشهد بسهولة، واعادة تشكيل المدن -تلك التي نقيم فيها- كما نرغب دون أن نقع في فخ المقارنة غير العادل.
ربما تستطيع بعض البيوت التي نسكنها، أن تلعب دور البيت الحقيقي كما نتخيل ونحب. لكن المكان يفشل في أن يمنحنا الشعور أننا تنتمي إليه.
كيف ستنتمي لمكان لا يمنحك الحب بالمجان كما مجانية الشمس في بيتك الأول؟
الحب المجاني الذي يتلفعك في وطنك من أهل عاطفيين وأصدقاء نزقين ستبحث عنه في وجوه جديدة، محاولاً فك شيفرات ملامحها، وربما تجد ما يشبهه؛ ولكن ليس بالمجان! عليكَ ببذل الجهد لتقدّم نفسكَ وتقنع الآخرين بمبررات انتمائك إلى المكان أو بأهليّتك الكاملة، وأن المعوقات من لغات وثقافة وقوانين لا تقف حائلاً لتكون ناجحاً ومستحقاً لذلك.
ولكن ماذا عن قسوة فشل الأماكن داخل أوطاننا بمنحنا شعور الانتماء؟
لا زلت أتذكر ما قالته لي معلمة طفلي منذ خمس سنوات عن أهمية تعاوننا مع المدرسة لجعل أطفالنا يشعرون بالانتماء للمدرسة، للمكان واللغات الرسمية هنا / الهولندية والفرنسية/، هذه المعلمة المولودة في بلجيكا ومن أصول مغربية ولا تتحدث العربية. أتذكر أنني قاطعتها على الفور في محاولة مني لرفض ما تقوله وأخبرتها أنني أبذل كل جهدي حتى أجعل طفلي منتمياً إلى لغتنا الأم، إلى ثقافتنا، عاداتنا وتقاليدنا العربية. يومها أجابت بهدوء: “حتى يتقن الأطفال لغةً ثانية عليهم أن يتقنوا لغتهم الأم أولاً. انتماء طفلك سيحمل أبعاداً أوسع من التي تتحدثين عنها، وكلما كان مدركاً لانتماءه لأصوله، كانت رحلة بحثه عن هويته أقل عناءً، ألا تعتقدي أننا متفقون؟”
إذاً هذه رحلة وليست هجرة كما يدّعون؛ رحلة بحث عن أفضل نسخة من الإنسان في عدة أمكنة وأزمنة. رحلة نتناول فيها الأيام مُعلبةً ومطابقة لمعايير جودة الحياة بينما نحنُّ لطعم أيامنا المنتهية الصلاحية في أوطاننا. ربما يختلف الناس بطريقة تعاطيهم مع المكان الجديد، ولكن من وجهة نظري ينقسم الناس لثلاثة أنواع:
–البعض يتنازل عن مكونات شخصيته، هويته وثقافته، يترك كل ذلك خلفه في بيوت طفولته وفي وطنه، ظناً منه أنه يتقن لعبة الاندماج مع المجتمع الجديد، وبعد عدة سنوات يصبح كالغراب الذي حاول تقليد طريقة الحمامة في المشي، وعندما فشل قرر أن يعود لمشيته، لكنه يكتشف أنه نسيها، فلا عاد غراباً ولا صار حمامة.
–البعض الآخر يقسّم روحه، أحلامه وذاكرته نتفاً صغيرة جداً. يملأ حقائبه بكل تلك النتف حتى تُتخم.
ثم يصل إلى المكان الجديد، يفرد حقائبه كلها مرة واحدة، وعندما يرى كل تلك النتف التي كوّنتهُ، سنواته وتاريخه كله في لحظة واحدة أمامه، يرتبك وينسى طريقة إلصاق وترتيب كل ذلك. كيف كانت كل مكنوناته مصفوفة ومحشورة بجانب بعضها بين غرف بيته الصغير في وطنه؟
كيف سيتأقلم مع فرز النفايات إذا كان معتاداً أن يرى تحوّل سطل السمنة الفارغ لزريعة الحبق دون أن يقلق على تغير المناخ أو يقلق بشأن دفع مخالفة بيئة؟
يشغل نفسه بلملمة كل هذه الأجزاء، في بيت لا يشبه بيته وأقفال الماضي توصد بابه إلى جيران لا يقولون “صبحك بالخير يا جاري!”.
وفي بيت لا يلملمُ ما يسقط من حبِّ قمحه وحُبّه.
– وأما ثالثهم هو من يقوم بكر كنزاته!
الكنزات التي حاكها بنفسه ولكن بمساعدة قلق أمه وديون أبيه. كنزاته التي لبسها كل أخوته وأصدقائه، والتي استخدمها لتغطية قطته عندما ولدت. كنزاته التي لبسها في العزاء كما في الأعراس.
يكرّها كلها ويحضر كُبب الصوف المتينة معه.
وعندما يصل يعيد تدوير الذاكرة، يخلط الألوان واللغات التي يتعلمها، يخلط ال هنا مع هناك مئات المرات حتى يصنع كنزات جديدة، مُحاكة بصوف انتماءه ومطرزة فقط بالتجربة الجديدة في البلاد التي يقيم فيها، وكلما وثب الحنين ثقيلاً رشيقاً في صدره، كانت قِبلته بيته في وطنه.
هجرة الفراشات
في حادثة سنوية غريبة، يقوم نوع من الفراشات بالهجرة بالآلاف من كندا إلى المكسيك في كل عام في أكتوبر ليقطع آلاف الكيلومترات. في بداية الربيع يتم التزاوج في بلد الهجرة المكسيك. الغريب أن الفراشات الصغيرة التي تنتج عن التزاوج تعود إلى موطن آبائها في كندا!
كيف تخرج الفراشات إلى الحياة بموهبة ربّانية بقدرتها على إيجاد طريق موطنها دون أن تتعلم ذلك من آبائها الذين يموتون في بلد الهجرة في الربيع؟ لطالما تساءلتُ لماذا لا تعيش الفراشات التي تفقس في موطن الهجرة حيث خرجت للحياة؟ هل لأنها لا تشعر بالانتماء للمكان الجديد أو أنها تشعر أنه غير مرحب بها، فتقودها غريزتها لتعود إلى أصولها؟
“قدمي اليمنى هنا وقدمي اليسرى هناك والمكانان لا يساعدان شعوري في الانتماء إليهما”
هكذا أجابني صديقي الذين يخبرنا في كل مرة نلتقي أن حلم العودة سيحققه فقط لسبب واحد، كي يطرق أبواب جيرانه وأصدقائه متى شاء وكلما أحسَّ بالضيق، ودون أن يأخذ موعداً قبل عدة أشهر كما يفعل هنا، فقط ليقول” أحتاجك يا صديق”.
في المساء وصلت البيت وقد أرهقني العمل والتحدث باللغة الهولندية طوال اليوم، بينما تتسابق خيول اللغة العربية في رأسي على طرقات لا تنتهي. وجدت طفلي يرسم طيوراً بأجنحة غريبة، طيوراً بأجنحة طويلة، ومنها قصيرة وملونة.
حسناً، ربما حصلت الآن على الإجابة التي بقيت ضائعة بين محطات الراديو:
“نحن طيور ونستطيع التحليق عالياً، ننتمي للسماء نفسها
لزرقتها واتساعها. لكن أجنحتنا التي قُصت عن عمد أو ربما بالخطأ في أوطاننا، جعلتنا نعتقد أن هناك سماءً أخرى قد ننتمي لها.
نسافرُ ونبحث عنها ونقيم تحت سماءات جديدة، هكذا نعتقد؛ لكننا نغفل أننا ما زلنا نطير تحت نفس السماء الواسعة، تلك التي تمدُّ ثوبها الطويل من أوطاننا الى أماكن غربتنا.